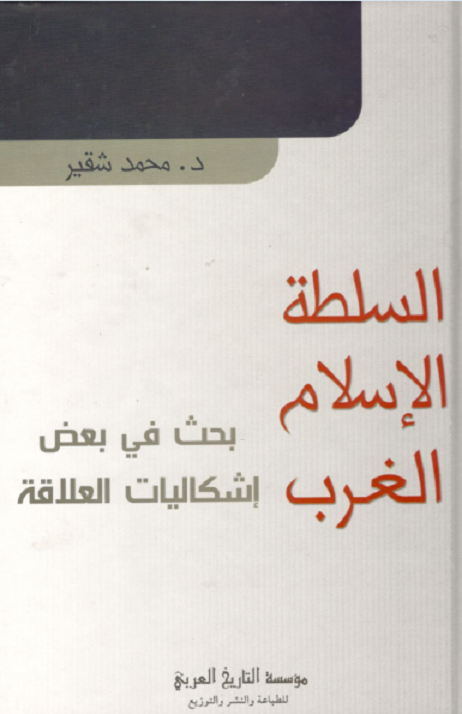المقاومة في مسارها

المقاومة في مسارها
قد يكون لمفهوم المقاومة لدينا من الحضور في الوعي والخطاب والوجدان والثقافة، وصولاً إلى الممارسة والدور، ما ليس لغيره من المفاهيم ذات الصلة.
وقد يكون هذا الأمر مفهوماً ومبرّراً، إذا استحضرنا تاريخ هذه الأرض وحاضرها، وما تعرّضت وتتعرض له من استعمار، واحتلال، وهيمنة على مدار التاريخ، وما كان يؤدّي إليه ذلك من استيلاد لفعل المقاومة، ودورها، ومشروعها، وثقافتها.
نحن هنا نتحدث عن روح - معنى-، هو من طينة هذه الأرض وتاريخها. نحن هنا نسوح في وعي، هو من خميرة الناس ووجدانها، ونحن نجول النّظر في محفل، هو من عجينة آلامها وآمالها، وحزنها وفرحها، وخوفها وأمنها، وتوقها إلى الحرية والكرامة، ورؤيتها للحاضر والمستقبل، وحلمها بوطن لا يترك أبناءه طعمة للغازي والمحتل.
لم تكن المقاومة بالنسبة إلى الكثيرين من أبناء هذا الوطن خياراً أيديولوجياً في أساسه، ينتجه ميلٌ إلى ممارسة التّرف الفكري، أو مجرّد بحث عن دور، أو انتماء، أو ما شابه ذلك، وإنّما كانت قبل أي شيء- وما زالت - خياراً متّصلاً بحاجة الناس إلى الأمن والأمان، وتوجهاً نابعاً من شعورها بعزتها وكرامتها الشخصيّة والوطنيّة، وأهمية الحفاظ على هذه الكرامة وصونها، وقراراً بحماية الأرض والعرض، وحفظ لقمة العيش، واستعادة دورة الحياة، وقناعةً بحقّهم في العيش بحرية وكرامة، دون أن يتهدّدهم أحد في حياتهم، وأمنهم، ورزقهم، وأرضهم، وسمائهم، وبحرهم، وسيادتهم، وفي جميع حقوقهم وشؤونهم، وحلّهم وترحالهم.
قد لا يستطيع البعض من أبناء هذا الوطن - بل من غيره - أن يشعر، أو أن يعي، ما الذي تعنيه المقاومة بالنّسبة إلى أهلها وناسها والكثيرين من أبنائها. وإذا ما التمسنا العذر لهؤلاء، فيمكننا القول بأنّهم لم يتحسّسوا المعاناة التي عاشها إخوتهم في الوطن، ولم يتألّموا آلامهم، ولم يتأمّلوا آمالاهم، ولم يقاسوا الخوف الذي قاسوه، ولم يختبروا الوجع الذي اختبروه، ولم يذوقوا المرارة التي كانوا يتجرّعون في كل صبح ومساء، وفي كل تفصيل من تفاصيل حياتهم ومعيشتهم، هذا فضلاً عن كل ذلك التشويه الإعلامي المنظّم الذي تتعرّض له المقاومة، والذي قد يكون أدّى إلى التباس الأمر لدى البعض، ممن تحول العصبيات الطائفية أو المذهبية دون أن يفهم بشكل صحيح أبناء وطنه؛ وما تسبّبه من عمى طائفي، يحجبه عن أن يعي منطقهم، و يتقبّل هواجسهم، ويحترم شعورهم، ولا يستخفّ بوجعهم، ولا يهمل توقهم إلى وطن يحميهم ويحمونه، ويعيشون فيه بحريّة وكرامة.
لكنّه - مع هذا - لن تستطيع أن ترتاح إلى من يشعرك بيانه أنّه لا يعبأ بهواجسك، ولا يحترم مخاوفك، ولا يشعر بألمِك، ولا يعير وزناً لأكثر من محنة، ومرارة، وجرح، بسببٍ من احتلال، أوغل في القتل، وأرعب، ودمّر، وهدم، وخطف، وعاث فساداً في البلاد والعباد. حيث لم يكشف البلاء، ولم يزح هذا الهمّ والغمّ عن صدور الناس، إلا فعل المقاومة.
إنّ ما تعنيه المقاومة في وجدان النّاس، ووعيهم؛ هو حريتهم، وكرامتهم، وأمنهم، وأمانهم، وخبزهم، وعيشهم، وحقّهم في الحياة والوجود. إنّها بالنّسبة إليهم ملح الأرض، ودرّة التّاج، وأيقونة النّاظر.
ولذلك يشعر أيٌّ من أولئك النّاس أنّ المقاومة قد كانت عند محنته، وأغاثته عند نكبته، وأنّها حقّقت له الحلم، وكانت له الأمل، وأنّها وفت له، إذ غدر به الأقربون والأبعدون، وأنّها كانت معه، ومن أجله، عندما تخلّى عنه جميع النّاس، وهجره الكثيرون، وتركوه يفتك به الاحتلال، ويضرسه بنابه، ويعتدي عليه عملاؤه، ويهلك لديه الحرث والنسل.
ولهذا، تجد أنّ كل المحاولات التي تستهدف شعب المقاومة تفشل، وأنّ كل المساعي التي تسعى إلى تسميم وعيه تخيب، وأنّ كل الجهود التي تروم إيمان الناس بها تذهب أدراج الرياح. فكيف يرجونه هجرانها، والجرح لمّا يندمل، والذكر طريّ العود، وما فارق طعم الأسى جوف الفؤاد.
قد لا يعي هؤلاء علاقة شعب المقاومة بالمقاومة، وسرّ إيمانهم بها، وسبب عطائهم لها، وكلّ هذا الدّفق والالتزام.. إنّه بالنّسبة إليهم بعضٌ من وفاء، وقليلٌ من واجب، وشيءٌ من دَين، ونسكٌ من دِين، وفعلُ إيمان، وصدقُ انتماء، وردّ العطاء بالعطاء، ووعيٌ للتاريخ والحاضر والمستقبل.
وعليه، لا تستطيع أن تكون حياديّاً أمام قضية كقضيّة المقاومة، ولن ترضى لنفسك الوقوف على التلّ، عندما ترى أنّها تُستهدف بالتلبيس والتدليس في فعلها، ووعيها، وثقافتها، ومكانتها، ودورها، وفي جميع ما أنجزت، وتنجز، للوطن، وإنسانه، وكرامته.
نعم، لا يستطيع كلّ من عاش مرحلة الاحتلال، وفعل التّحرير، أن يكون حياديّاً في معركة الدفاع عن المقاومة وحفظ ألَقِها، لأنّه يشعر في خبيئته أنّه يذود بجوده عن وجوده، وبعطائه عن بقائه، وأنّه يدافع بفعله عن نفسه، وعن صميم كرامته، وعن حقّه في الأمن، والحياة، والوجود.
إنّ من يتتبّع المسار التاريخي للمقاومة منذ حوالي أربعة عقود إلى الآن، يجد أنّ هذه المقاومة وإن بدأت في إطار محلّي - على مستوى الفعل -، لكنّها انتقلت إلى إطارٍ إقليمي، بل انضوت في إطارٍ صراعيّ مع قوى دولية، ومع الولايات المتحدة الأميركية تحديداً، وهو ما يرتبط بطبيعة الاستهداف الذي تتعرّض له المقاومة، وتالياً الدّفاع الذي تمارسه. إذ إنّه عندما يتحول الهجوم على المقاومة إلى مشروعٍ ذي أبعاد إقليميّة ودوليّة، فمن الطّبيعي أن يأخذ مشروع الدّفاع عن المقاومة الأبعاد نفسها، الذي أخذه الهجوم عليها واستهدافُها، وهو ما يرتبط بقانون الفعل وردّ الفعل، وسعي المقاومة إلى حماية نفسها وأهلها، ممّا يحاك لها على مستوى الإقليم والمنطقة.
وهو ما أفضى إلى أن يجد الساعون إلى تشويه المقاومة وإضعافها مادة جديدة لهم، حيث بدأ الاتّهام يتضمّن بعداً مذهبيّاً، أو قوميّاً غير عربي، من قبيل المشروع الفارسي والإيراني، وسعيه إلى توسيع نفوذه في المنطقة، وتصدير الثورة، ونشر التشيّع، وغيرها من الاتهامات التي تتهاوى مع أدنى تأمل عقلاني فيها، أو نظر موضوعي لها.
فلو أخذنا على سبيل المثال الاتهام بالمذهبية، فلنا أن نسأل:
- هل فلسطين شيعية، حتّى يُتّهم من يعين شعبها ومقاومته بالدافع المذهبي؟
- لو كان الدّافع المذهبي هو الأساس في الصّراع القائم في المنطقة؛ ألن يؤدّي التصالح مع أميركا، إلى أن تُفتح أبواب العالم لنشر التشيّع، كما فعلت الولايات المتحدة، وكثير من الدول الغربيّة، أمام مذاهب أخرى، بفعل المصالح الاقتصادية، ولُعاب النّفط، والتحالف السياسي، وغيره؟
- لو كان الدافع المذهبي هو الأساس، ألن يفضي التخلّي عن إعانة الشعب الفلسطيني ومقاومته إلى أن ينعم الوجود الشيعي في المنطقة، بل في العالم، بكثير من الخيرات، وأن يريح نفسه من كثير من الشدائد، وأن يتجاوز العديد من المِحن، التي يعانيها بسببٍ من موقفه من قضيّة فلسطين، وانخراطه في مشروع المقاومة والتّحرّر؟
ألن يسهم التخلي عن مشروع التحرّر والاستقلال في أن يصبح حال بعض المكوّنات - أو الأقليّات - الشيعيّة أفضل ممّا هو عليه في أوطانها وبلدانها، وأبعد عمّا تلاقيه من تمييز، واضطهاد، ومعاملة غير منصفة، من قبل العديد من الأنظمة في عالمنا العربي والإسلامي؟
وبالإضافة إلى مجمل ما تقدّم، كيف تفسّر ذلك الحضور الفاعل والقوي للعديد من حركات المقاومة ذات المرجعية السنيّة في مشروع المقاومة في المنطقة، جنباً إلى جنب مع تلك التي تنتمي إلى مرجعية شيعية؟ ألا يعني ما تقدّم أنّ هذا المشروع يتجاوز تلك الأبعاد المذهبية في مضمونه التحرّري، والاستراتيجي، والقيمي، والإسلامي، والإنساني؟
أمّا عن اتّهام هذا المشروع بالقوميّة، والفارسيّة تحديداً، والسّعي إلى توسيع النفوذ في المنطقة من قبل هذه الدّولة، أو تلك (الجمهورية الإسلامية في إيران)؛ فلا بدّ من الإجابة على هذا الاتّهام بما يلي:
- الحضور العربي في مشروع المقاومة في المنطقة، ليس أقلّ من الحضور غير العربي فيه.
- لو كان الهدف لما يسمّى بالمشروع الإيراني - من قبل هذه الفئات المعادية للمقاومة وإعلامها -، هو توسعة النفوذ في المنطقة؛ لكان أقصر الطّرق إليه هو التحالف مع أميركا، وإنهاء العداء مع الكيان الإسرائيلي. عندها سوف تعود إيران لتكون شرطي الخليج - إن لم يكن المنطقة - كما كانت في عهدها السابق، ولرُفعت عنها العقوبات المفروضة عليها منذ ما يقارب الأربعة عقود، وفتحت لها الأبواب في العالم اقتصاديّاً وسياسيّاً وغير ذلك، ولما أصبح من مانع في أن تكمل مشروعها النووي من دون قيود أو ضغوط من قبل العديد من الأطراف الدّوليّين، ولأُعطيت من الحضور والنّفوذ في المنطقة أكثر بكثير ممّا هي عليه اليوم.
- لو كان الانخراط في مشروع المقاومة في المنطقة مدخلاً إلى هذا النّفوذ، بالطّريقة التي يتحدّث بها الخطاب المناوئ للمقاومة؛ فلماذا لا تنخرط تلك الدول التي تتمسّك بهذا الخطاب في مشروع المقاومة هذا، فتحصل من جهة على هذا النفوذ المدّعى، وتقطع الطريق من جهة أخرى على تلك الدّولة والجهات، التي - بحسب دعواها – تستغلّ هذا المشروع لبسط نفوذها في المنطقة؟
والجواب ببساطة، هو أنّ الانخراط في مشروع المقاومة يستلزم فعل إيمان، وعقيدة تحرّر، ويحتاج إلى استعدادٍ خاص، لتحمّل كلفة المقاومة، وضريبة الاستقلال، وثمن الحريّة، وتضحيات الكرامة، وصبر الجهاد، ومشقّة التّحرير، وهو ما لا يستسيغه إلّا القلّة من النّاس وخُلّصُهم.
وعليه، يمكن القول إنّ مشروع المقاومة في المنطقة ليس مشروعاً مذهبيّاً أو قوميّاً، وإنّما هو مشروع قيمي، أخلاقي، إنساني، ديني، إسلامي... يمكن أن تلتقي عليه وفيه مجمل الأديان، والمذاهب، والقوميّات، والمدارس الفكريّة، إن كانت تؤمن بهذه القيم المشتركة، التي يستند عليها هذا المشروع ونهجه، من الحريّة والعزّة والكرامة والاستقلال والعدالة والإنصاف، وغيرها من القيم ذات الصّلة.
ثمّ ما المانع في أن تجتمع جميع القوميّات، أو المذاهب، أو القوى، على هذا المشروع، وتنخرط فيه، طالما أنّه يملك أرضيّة قيميّة مشتركة تجمع الجميع، وتحضن أطرافه؟
وإن كان الهدف هو تعزيز مشروع المقاومة في المنطقة، ألن يكون عندها أمراً جيّداً أن تنخرط فيه مختلف الجهات المؤثّرة لديه، طالما أنّ انخراطها فيه، يؤدّي إلى تقويته، وتعزيز فرص نجاحه؟
ثمّ لمصلحة من إثارة العصبيّات المذهبيّة، أو القوميّة، أو الدّينيّة وغيرها؟ هل يخدم ذلك قضيّة التّحرّر والاستقلال والمقاومة، أم إنّه يخدم أهداف الاحتلال والاستعمار والتّبعيّة؟
ثمّ هل يُعاب على من انخرط في مشروع المقاومة - مهما كان لونه، أم عرقه، أم مذهبه، أم دينه وطائفته... أم إنّه يعاب على من تخلّف عن هذا المشروع، وخالفه، وخاصمه، وعاداه، وارتضى لنفسه أن يكون بيدقاً يخدم مشروع الاحتلال والاستعمار، بمعزل عن المبرّرات، والخلفيّات، والذّرائع الواهية.
وإن قال قائلٌ: فلنتمسك بحيادنا، ونبحث فقط فيما يكون فيه مصلحة وطننا، من دون أن ننشغل بغيره؛ فالجواب: هل يشك أحدٌ في أن ضعف إسرائيل مصلحة للبنان؟ وهل يناقش أحدٌ في أن إسرائيل عندما كان لديها فائض من القوة، وعوامل أخرى مساعدة، فإنها أقدمت على أكثر من عدوان على لبنان واحتلال..؟ وهل من ريب في أن إسرائيل عندما تقوى على مستوى المنطقة، تصبح الخشية على لبنان أشدّ، وفي المقابل، عندما تصبح عوامل الردع لها أوسع وأقوى في المنطقة، يكون في ذلك حصانة أشدّ للبنان وحمايته؟ وهل يقدح ذو لبٍّ في منطقٍ مفاده، أن الاستهداف عندما يأخذ أبعاداً تتجاوز الإطار المحلي، فمن المنطقي أن يأخذ الدفاع الأبعاد نفسها؟ وهل يجافي أحد حقيقة أنّ أي بلدٍ تختلّ فيه موازين القوى لصالح عدوّه، فإنّه يسعى إلى بناء منظومة تعاون وعلاقات، تعوّض اختلال منظومة القوى تلك، وتجبُر ضعفها؟ وإذا كان لا بدّ من مفردة الحياد، فليُعمل على اجتراح مضمون لهذا الحياد ومحتوى يتناسب والمصلحة اللبنانية. أليس الحياد القائم على قوّة لبنان في وجه العدوان الإسرائيلي، والإرهاب التكفيري، ومحاولات إخضاعه وإضعافه من أيّ جهة كانت؛ بل قوّته في كل شيء: في اقتصاده المنتج، ونظامه المالي والنقدي، وفي استقلاله وسيادته الحقيقية، وفي وحدة أبنائه، وتضامنهم فيما بينهم؛ هو ما يخدم مصلحة لبنان، وحمايته، وجميع مواطنيه؟
وآخر فصول السعي إلى تشويه المقاومة وإضعافها، محاولة تحميلها مسؤوليّة ما آل إليه الوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان؛ وفي هذا افتئات على الحقيقة، ومجافاة للمنطق والعلم، واستخفاف بالعقول، وتعدٍّ على النّاس، عندما يمارس التّضليل بحقّهم؛ وتبرئةٌ للمرتكب، عندما تُلبس التّهمة غير أهلها، ويُعمل على نفيها عن مرتكبها.
إنّ ما ينبغي قوله، هو إنّ هذا المشروع يكمل خطواته بنجاح وثبات على مستوى المنطقة، وإنّ طبيعة التزيّل التي تحصل على مستوى الأنظمة والمجتمعات، ومختلف الجهات والأفراد في عالمنا العربي والإسلامي، على أساس من خيارات المقاومة والتّحرّر؛ هي في خدمة هذا المشروع، لأنّه عندما يحصل الانقسام البيّن، والتّموضع المكشوف، هنا تصبح الحقائق في كامل الوضوح أمام الشعوب والمجتمعات لحسم مواقفها، وتحديد تموضعها، ويكون عندها بعيداً عن أيّ التباس من هو في صفّ المقاومة، ومن هو في صفّ أعدائها.
إنّ من يقرأ مسار مشروع المقاومة والتّحرّر في المنطقة خلال العقود الماضية، من جهة مراكمته المتصاعدة لعوامل القوّة وعناصرها، وتحقيقه للنّجاح تلو النّجاح؛ يستطيع - بناءً على ما تقدّم وغيره من المعطيات ذات الصّلة - أن يمارس نوع استشراف، لما يمكن أن يكون عليه الحال في السّنوات القادمة، وأنّ يتوقّع بشكل علمي – يعضده أكثر من فهمٍ فلسفي – مبني على أساس من قوانين الاجتماع وسُنن التّاريخ؛ أنّ هذا المشروع يقترب يوماً بعد آخر من تحقيقه النّصر الذي يأمل، وبلوغه الهدف الذي يرتجي.
وعليه، قد يكون من المفيد أن تنكشف الأمور على حقيقتها، وتتبدّى من دون قناع، سواءً في الأنظمة أو المجتمعات أو الجهات على اختلافها، قبل الوصول إلى تلك المآلات، وبلوغ الفتح، حتّى تظهر معادنُ النّاس على حقيقتها، وليُعلم النّصرُ من هم أهله، وإلى من يعود نسبه، وليُعلم الخذلان من ذيلِه إلى نعلِه.
أمّا التّوصية التي أجد من المناسب الإلفات إليها في هذه المقدّمة، فهي أن يُعمل على الارتقاء بمشروع المقاومة إلى مديات أوسع، ورُؤى أشمل ليأخذ أبعاداً مختلفة وشاملة، تحيله إلى مشروعٍ حضاريّ ذي مضامين متكاملة في المعرفة، والفكر، والثّقافة، والفنّ، والاقتصاد، والسّياسة، وغيرها، ليكون بمثابة بديل حضاري، في سياق البحث عن الخيارات الحضاريّة، أمام ما تعانيه العولمة من أزمات في أكثر من ميدان ومجال.
لكن هذا يتطلّب بناء هذا المشروع الحضاري أو تكميله، بحيث يكون البعد المقاوم - بما يعنيه من فعل استقلال وعزّة وكرامة وحريّة - أحد أضلاع هذا المشروع، لتضاف إليه أضلاعٌ أخرى، تشكّل في مجملها منظومة شاملة ومتكاملة، تقوم على أساس قيميّ أخلاقي، محوره العدالة في مفهومها الفلسفي والمطلق، والإنصاف في مضمونه القيمي والأخلاقي. وهو ما كان لنا فيه أكثر من مؤلّف ومقال، يطلب من مظانّه.
إنّ النّظر إلى مشروع المقاومة من ضمن مشروعٍ حضاريّ أشمل، لا ينتقص من فعل المقاومة، ولا يفقدها ترتيب أولويّاتها في واقع تاريخيّ معيّن، وإنّما سوف يكون عاملاً أساسيّاً في إطار تثمير هذا المشروع ونتائجه، بناءً على مقاصد وأهداف عليا وأبعد، وفي سياق إدارة هذا المشروع (المقاوم) بطريقة هادفة أكثر، وفي تنظيم بقيّة الأولويّات ذات الصّلة، وإعطائها حقّها من الاهتمام والعمل، بل في إدارة مجمل مداميك هذا المشروع الحضاري، بطريقة أكثر تكاملاً وتنسيقاً، بحيث يرفد بعضه بعضاً، ويساعد بعضه البعض الآخر، بما يؤسّس لمواجهة حضاريّة شاملة، تقوم بالدّرجة الأولى على أساس المضمون القيمي والأخلاقي (العدالة الشاملة)، وتستنفر جميع الطّاقات والإمكانيّات في شتّى المجالات والميادين، ولا تدع مجالاً للضّعف أو النّفاذ من أيّ من مساحات الاجتماع الإنساني العام، وحقوله، وميادينه.
إنّ ممارسة أولويّةٍ ما في سياق تاريخيّ أو آخر، يجب ألّا تجعلنا نبتعد عن رؤية هذا البعد الحضاري في المواجهة، وعن معاينة بقيّة الأولويّات، وعن رؤية الصّراع ضمن سياق منظومي شامل ومتكامل، لأنّنا إن وقعنا في هذا، أو في شيء منه؛ فقد نفتقد القدرة على التّوظيف الحضاري، وعلى الارتقاء بذاك المشروع إلى مدياته الأوسع، وعلى ملاحظة بقيّة الساحات والأضلاع والتّكامل والتّنسيق بينها، وعلى دفع ذلك المشروع والتّقدّم به إلى ميدان العولمة، وصراعاتها الحضاريّة، ومجمل خياراتها الفكريّة.
أي إنّ المطلوب الارتقاء من أقلمة المشروع المقاوم (إعطاؤه بعده الإقليمي)، إلى عولمة هذا المشروع، وتقديمه كنموذج إنساني معاصر لجميع الأمم والشعوب الساعية إلى الاستقلال والتحرّر والعدالة، وتظهيره ضمن مشروع حضاري شامل ومتكامل، يستوعب جميع الأبعاد الحضاريّة والإنسانيّة الأخرى، التي تحيله إلى نموذج حضاري يتقدّم على البدائل الأخرى، وإلى بديل إنساني عن تلك الخيارات، التي فشلت وتهاوت، أو هي في طريقها إلى ذاك المآل، وتلك الخاتمة.
وخصوصاً أنّ نواة هذا المشروع الحضاري مورد التّوصية موجودة، وهي تكمن في ذاك المشروع المقاوم والإنساني على مستوى المنطقة، في مختلف امتداداته، وتجلّياته، وأضلاعه؛ وأنّ مختلف مقوّمات ذلك المشروع الحضاري حاضرة، من الأساس القيمي، والأخلاقي، والفكري، وغير ذلك، ممّا يحتاج إلى إعادة بنائه، أو إنضاجه، أو تثميره... وهو ما يرتّب مسؤوليّات كبيرة وضخمة على حَمَلة هذا المشروع والمؤمنين به، عندما يراد له أن يكون بديلاً حضاريّاً، وطريقاً ثالثاً، أمام ما تعانيه العولمة من أزمات، وما يشهده العالم من انسداد حضاري، وما تكابده الإنسانيّة من ضياعٍ، وما يواجهه الاجتماع البشريّ من تيهٍ على أكثر من مستوى ومجالٍ قيميّ، وأخلاقي، وثقافي، وفكري، واقتصادي، وسياسي، واجتماعي، وغيره.
عدد قراءات المقال : 968
تعليقات الزوار
جديد الموقع