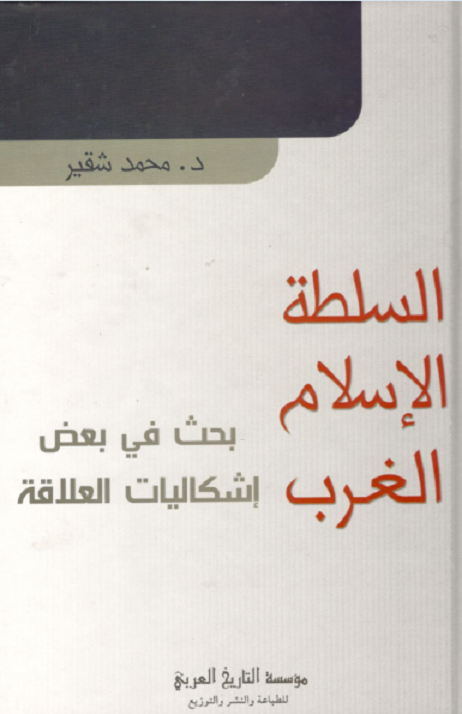في ماهية العدالة والجوهر الأخلاقي

في ماهية العدالة والجوهر الأخلاقي
لعلّ من أصعب الأعمال أن تعمد إلى مفهوم ذي بعد تجريدي، لتبحث في ماهيته، وتعمل على تفسيره أو تعريفه، أو حتى إيضاحه.
مفهوم العدالة هو واحد من هذه المفاهيم، الذي إذا أردنا الحديث مفصلاً في بيانه وتجلّياته، فلربما يحتاج الأمر إلى معالجة تستلزم البحث في تجليات العدالة في مختلف الميادين والمجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، وغيرها. وهذا خارج عن حدود هذه المقالة وهدفها.
هنا سوف نقتصر على إيضاح هذا المفهوم، ليتمّ التركيز على جوهر العدالة وماهيتها، والتي تتصل بالجانب القيمي والأخلاقي بشكل أساس، إذ إنّ تحديد جوهر هذا المفهوم وماهيته، يساعد على تشخيص الرؤية (والمشروع المنبثق عنها) التي يجب أن تعتمد لإقامة العدالة، وبناء مجتمع العدالة، وثقافة العدالة... لأن مضمون تلك الرؤية، وما ينبثق عنها من مشروع، وسياسات، وبرامج... كل ذلك إنما يرتكز على تحديدنا لجوهر العدالة وماهيتها، فإذا ما قلنا إنّ تلك الماهية هي ماهية معرفيّة بالدرجة الأولى، فهذا يترتّب عليه جملة من النتائج، أما إذا قلنا أن تلك الماهية هي ماهية قيمية بالدرجة الأولى، فهذا يترتّب عليه نتائج أخرى.
لكن بدايةً من المفيد الإشارة ولو بشكل مختصر إلى أهم سمات أو مواصفات، العدالة ومضمونها، حيث يمكن القول إن العدالة تتصف بجملة مواصفات هذه أهمها:
- الفطرية: بمعنى أن طبيعة الخلقة البشرية تختزن معنى العدالة وإدراكها، ولو بصورتها المبدئية والأولية، وإمكانية العمل بها وبلوازمها.
- الإنسانية: أي إن مفهوم العدالة هو مفهوم غير قابل للاحتباس في إطار فئوي، أو طائفي، أو عرقي، أو جغرافي، أو قومي... وإنما هو مفهوم عابر لجميع تلك الحدود والحواجز المصطنعة.
- الشمولية: بمعنى أنه يشمل جميع المجالات الاجتماعية والفردية، النفسية والخارجية (الواقع الخارجي)، ومختلف الميادين السياسية، والأسرية، والإدارية، والمالية، والقانونية، والتربوية، والأخلاقية، والعلمية...
- الإطلاقية: بمعنى أن قيمة العدالة هي قيمة متقدمة على أية قيمة أخرى، فلو فرضنا أنه حصل تزاحم (تنافٍ) بين العدالة وبين قيمة أخرى - كالحريّة مثلاً - فالقيمة التي تقدّم هي قيمة العدالة وليس الحريّة، أي ينبغي أن تقيّد الحريّة بالعدالة، وليس من الصحيح أن يحصل العكس، أي أن تقيّد العدالة بالحريّة.
- التجريدية والعملية: أي إن مفهوم العدالة يحتوي على بعديه التجريدي والنظري من جهة، والتطبيقي والعملي من جهة أخرى. وهو ما يترتب عليه جملة من المستلزمات، والتي منها أن البحث النظري يجب أن يكون هادفاً إلى الآثار العملية، وينبغي أن تترتب عليه نتائج واقعية في مجمل الحقول والمجالات.
هذه العناوين ربما تشير إلى أهم مواصفات العدالة وسماتها، وسوف نقتصر على هذه الموارد، لننتقل إلى بيان إيضاحي مختصر للعدالة، أو بيان موجز يوضح مفهومها، كما جاء في بعض الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت(ع)، حيث قال الإمام علي(ع): "العدل الإنصاف".([1])
لكن نجد في جملة من تلك الروايات توضيحاً أو تفصيلاً يرتبط بشكل أو آخر بهذا التّعريف السّابق، من حيث إن تحقيق الإنصاف ربما يحتاج إلى أن يكون للمرء القدرة على تحقيق التّوازن في علاقته مع الآخر، بأن تكون لديه القدرة على أن يضع نفسه مكان الآخر وحيثيّاته وظروفه وأوضاعه، ثم يحاول تقدير الموقف والشعور والصائب من الفعل.
وهذا ما يحتاج إلى العصمة من محوريّة الأنا (عبادة الهوى)، وتجاوزها إلى عبادة الله الحقّة، واتّباع الحقّ، ومنتهى الصّدق في العمل به.
أما تلك الروايات فهي ما يلي:
عن رسول الله(ص): "أعدل الناس من رضي للناس ما يرضى لنفسه، وكره لهم ما يكره لنفسه".(2)
وعن رسول الله(ص)، وقد قيل له: أحبُّ أن أكون أعدل الناس [فقال(ص)]: أحِبَّ للناس ما تحب لنفسك، تكن أعدل الناس".(3)
وعن الإمام علي(ع): "أعدل السيرة أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به".(4)
وعن الإمام علي(ع): "إنّ من أحبّ عباد الله إليه عبداً أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن، وتجلبب الخوف... فهو من معادن دينه، وأوتاد أرضه، قد ألزم نفسه العدل، فكان أوّلُ عدله نفي الهوى عن نفسه".(5)
وهذه الروايات وغيرها تظهر البعد الأخلاقي الماثل في العدالة، بمعنى أنه صحيح من جهة أنّ هناك بعداً نظرياً ورؤيوياً وفكرياً للعدالة، لكنه يصح القول من جهة أخرى إنّ العدالة تحتاج بشكل أساس إلى البعد الأخلاقي، وإلى قيم أخلاقية فاعلة ومؤثرة، وإلى تربية أخلاقية هادفة تنتج بصيرة أخلاقية نافذة، أي تنتج ضميراً قادراً على تلمس العدالة ومواردها، وتصنع وجداناً باستطاعته تحسّس العدالة ومصاديقها، ويكون لديه كل الدافع إلى الالتزام بها، وجميع القدرة على مغالبة تلك الموانع التي تعمل على تعطيل رؤيتها والعمل بها.
إنها بصيرة العدالة، أو بصيرة أخلاقيات العدالة، أو فلسفة أخلاقية للعدالة، لا ترى في العدالة أمراً معرفياً محضاً، يمكن للعقل النظري المجرّد عن القلب والوجدان والضمير أن يتلمسه، أو يلتزم به، ويعمل بفحواه. إنما ترى فيه معطى له منبعه النظري، لكن جوهره يُستحصل بالفعل الأخلاقي والتّكامل المعنوي والتّربوي.
إن من نتائج هذه المقاربة أن صناعة العدالة، وبناء مجتمع العدالة، وحضارة العدالة؛ كل ذلك يحتاج بالدرجة الأولى إلى البناء المعنوي، والتكامل الروحي، والفعل الأخلاقي، والعمل التربوي، فحتى يكون المر عادلاً، لا بد له من العمل على تربية نفسه تربية صالحة، وتخليقها بالأخلاق الطيبة، وتأديبها بالأدب الحسن. وكذلك الأمر عندما يكون الحديث في المجتمع، والأمة، والمؤسسة، والمدرسة، والجامعة، والوطن، والدولة...
إن من نتائج هذه المقاربة أن فعل العدالة يحتاج بالدرجة الأولى إلى التربية على العدالة، وأن صناعة العدالة تحتاج بشكل أساس إلى مشاريع تربوية، وسياسات تربوية، وبرامج تربوية. إنها تحتاج إلى أن نقدّم إجابات عملية ووافية وكافية على هذه الأسئلة:
كيف نربّي أبناءنا ومجتمعاتنا على العدالة وقيمها؟
كيف نحوّل العدالة إلى قيم تربوية، تقبل التسييل في المدرسة، والإعلام، والأدب، والجامعة، والأسرة، والمجتمع...؟
كيف نبني رؤية تربويّة، وسياسات تربويّة، وبرامج تربويّة ترتكز على العدالة، وتهدف إليها؟
وهذا يتطلب حركة نشطة، ومبادرة فاعلة، من جميع المهتمين بالشأن الأخلاقي والتربوي والقيمي، من أجل وضع خطط وبرامج لبيان العدالة، وتسييلها، وتفصيلها، وأخذها إلى جميع المسارب والمشارب التربوية والثقافية، التي تؤثر في المجتمع، وفي عامة الناس، بهدف الاستفادة من جميع الوسائل والإمكانيات لممارسة التربية على العدالة، وإفشاء ثقافة العدالة وقيمها.
وهذا يعني أن من يتبنّى العدالة في السياسة، والاجتماع، والاقتصاد، وفي صناعة المجتمعات والدول ووظائفها؛ عليه أن يبدأ من التربية، أي التربية الصالحة والفاعلة، التي ترتكز على تلك الرؤية الحقّة، والقيم الصحيحة، وتستند إلى فلسفة واقعيّة للوجود، والخلق، والحياة، والموت، والفعل الإنساني... تقود كلها إلى العدالة، وقدسيتها، وأهميتها، وأهمية الأخذ بأسبابها، والعمل بقيمها، وولوج أبوابها.
وإنّ مما يستفاد من هذه المقاربة، هو أن المستوى المعنوي والقيمي والأخلاقي والروحي الذي يبلغه أي مجتمع؛ هو المرتكز والأساس الذي يمكن الاعتماد عليه للقول، بأن هذا المجتمع يمكنه أن يحقّق هذا المستوى أو ذاك من العدالة وقيمها، أو هذا المدى أو ذاك من القسط وأهدافه، فبمقدار ما يرتقي هذا المجتمع أو ذاك في مسيره المعنوي والأخلاقي والروحي، بمقدار ما يستطيع أن يقيم بالمستوى نفسه من معاني العدالة وقيمها. وبمقدار ما يتخلف عن الإرتقاء في مسيره ذاك بمقدار ما يتخلف عن إقامة العدالة وكلمتها.
بل يمكن القول من جهة أخرى إن تخلف أي مجتمع عن إقامة العدالة في مختلف المجالات الاجتماعية أو ضعفه في ذلك؛ إنما هو مؤشر على تدنّي المستوى الأخلاقي لدى ذلك المجتمع، أو ضعفه المعنوي، أو تخلّفه على مستوى القيم الروحية لديه.
ويستفاد ممّا تقدّم أنّه إذا أردنا أن نعرف المستوى الأخلاقي لأي مجتمع، فما علينا إلّا أن نلتفت بشكل أساس إلى قدرته على إقامة العدالة. وإذا أردنا أن نعرف المدى الذي بلغه هذا المجتمع أو ذاك في تكامله الروحي ومسيره المعنوي، فما علينا إلّا أن نلتفت بالدرجة الأولى إلى مقدار ما يقيمه من عدالة في جنباته، ومختلف ميادينه ومجالاته.
إنّ المدى الذي يبلغه أي مجتمع في إقامة العدالة في الاقتصاد، والإجتماع، والإدارة، والسياسة، وفي توزيع الثروات، وفي سياسسات الدخل، والسياسات الضريبية، وغيرها؛ هو المؤشر الحقيقي على المدى الذي قد بلغه هذا المجتمع في مستواه الأخلاقي، ومساره الديني، وميسره الحضاري... وليس المؤشر في ذلك هو مستوى الرّفاه العام الذي وصل إليه، أو نسبة الدّخل القومي، أو بعض مظاهر العمران العام، أو الحداثة العمرانيّة والظّاهريّة، أو بعض التّقدّم العلمي والصّناعي، أو مدى إستجابته للإحتفاليات الدينية واهتمامه بها وإقامته لها.
إن مدى الرقي الديني لأي مجتمع يقاس بمدى إقامة العدالة وقدرته على تسييلها في جميع الحقول الاجتماعيّة، ولا تقاس بمدى حداثته العمرانيّة أو الصّناعيّة، أو بمدى إقامته للإحتفالات الدينية.
وإنّ الدرجة التي يبلغها أي مجتمع في استجابته للرسالات الإلهية والتزامه بها، تعرف من خلال ما يقيمه من قسط، ويحققه من عدل بين الناس وفيهم، وليس من خلال الظاهراتية الدينية ومجمل ما يرتبط بها أي إن التّديّن الحقيقي والفعلي لأي مجتمع إنّما يعرف من خلال ما أقامه من عدل في الاقتصاد والمجتمع والمال وفي مختلف المجالات، وما حقّقه من إصلاح في مجمل الميادين، وليس من خلال ما يقيمه من احتفالات، أو يرفعه من شعارات. العدالة هي المؤشر الحقيقي لتديّن أي مجتمع، ومدى عصمته من الظلم هو الميزان الأساس لورعه الدّيني.
إنّ من أهم التوصيات التي يمكن أن يخرج بها هذا المقال، هو أن على تلك المجتمعات والجهات الدينية، وخصوصاً تلك التي تلتزم بمدرسة أهل البيت(ع) ومخزونها المعرفي والمعنوي والأخلاقي، أن تعمل على الاستفادة بشكل أفضل من ذلك المخزون القيّم، والغني، والعميق، الذي تمتلكه تلك المدرسة، وذلك بهدف بيان جميع ما في ذلك المخزون من معارف أخلاقية، وقيم تربوية، ومعانٍ روحية... والعمل على تسييلها في الخطاب، والإعلام، والتربية، والعمل على رفع المنسوب الأخلاقي والتربوي في جميع مناحي الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسة وغيرها.
يبقى أن نشير أخيراً إلى أن تلك المدرسة - بما تعبر عنه من منظومة دينية - تملك فلسفة للوجود والخلق والحياة والإنسان، ورؤية كونية، ومنظومة أخلاقية، وبعداً معنوياً، ومخزوناً روحياً، وتراثاً معرفيا وفكريا، بما يتيح لها أن تحقّق مدى أبعد من العدالة، ومستوى أرقى من القسط. طبعاً فيما لو استطعنا أن نفقه جوهر الدين ورسالاته القائم على إقامة القسط، وفيما لو أدركنا بوعي وعمق القيمة الدينية والأخلاقية والمعنوية التي تتصف بها تلك المدرسة، وعملنا بصدق وإخلاص على الإستفادة منها واستثمار معانيها وكان الولاء والإنتماء حصراً وقصراً للعدل وأهله وللقسط وقومه.
1- الريشهري، ميزان الحكمة، مؤسسة دار الحديث الثقافية، بيروت، ط2، ج4، ص1840، 2، و3، و4، و5: م ن، ص1842و1843.
عدد قراءات المقال : 3227
تعليقات الزوار
جديد الموقع