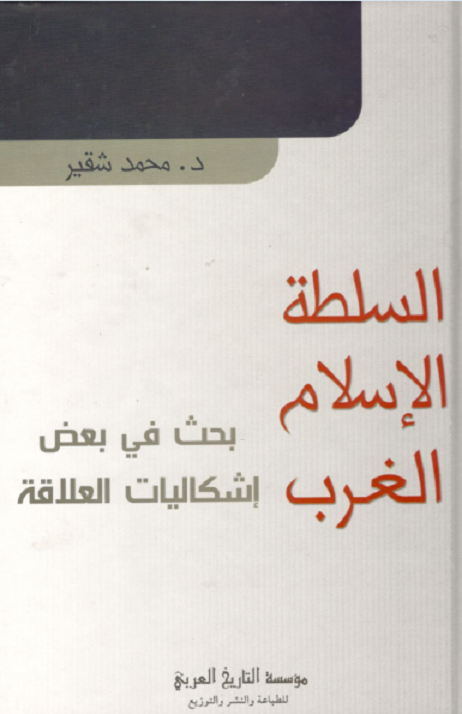لاهوت التكفير وإشكاليات التفسير والتوظيف

لاهوت التكفير
وإشكاليّات التفسير والتّوظيف
يتمحّور هذا البحث حول ما يمكن تسميته ب(لاهوت التكفير)، وما يرافقه من إشكاليات تدور حول تأويل النصّ الديني، وكيف أسهم التأويل السلطاني في صناعة ذلك اللاهوت، وأهم النظريات المفسّرة لظاهرة التكفير العدواني، والتي تقتات على ذلك اللاهوت، والأسباب التي تسهم في جعل هذه الظاهرة ذات قابلية للتوظيف في مشاريع الفتنة والتباعد بين المسلمين.
ومن هنا سوف نقسّم هذا البحث إلى ثلاثة عناوين، الأول ويتناول لاهوت التكفير ونشأته التاريخية، والثاني ويتناول النظريات المفسّرة لظاهرة التكفير ونقدها، والثالث ويتناول الأسباب التي تجعل من حركات التكفير مطيّة يسهل ركوبها لتحقيق أهداف المشاريع الاستعمارية في بلادنا ومجتمعاتنا، كما هو حاصل في ايامنا هذه.
أولاً: لاهوت التكفير:
يتحدّث القرآن الكريم في تحريف كلام الله والكلم في أربع آيات، وفي كتمان الكتاب وما أنزل من البيّنات والحق في حوالي ست آيات، وفي لبس الحقّ بالباطل في آيتين، وفي قول الكذب على الله تعالى وافترائه عليه في عشرات الآيات... إلى غيرها من الآيات القرآنيّة والنّصوص الحديثية - وهي بالمئات - والتي تبيّن حقيقة دينيّة وتاريخيّة واجتماعيّة... وهي أن الدين لا تقف تحدياته عند مرحلة التنزيل، وإنّما يتعدّاها إلى مرحلة التّأويل، بل يمكن القول، إن صراع التّأويل هو أكثر صعوبة، وأشدّ خطراً من صراع التّنزيل.
وتوضيح ذلك، أن الدّين عندما ينزّله الله تعالى، فإنّه يدعو بشكل أساس إلى منظومة من المفاهيم والقيم الأخلاقيّة والإنسانيّة والإجتماعيّة... وعلى رأسها العدل والقسط، وهذه الدعوة تشكل تهديداً لمصالح قوى وجماعات كالمترفين، والظالمين، والمفسدين، والمنافقين (لاحقاً)، وقوى السلطة والمال، والقوى التّقليديّة المناهضة لأي تغيير يمسّ مصالحها ونفوذها... فتعمل هذه القوى والجماعات على مواجهة الدّين في مرحلة التّنزيل - أي مرحلة تثبيت نصوصه الأولى والأصليّة - حيث تكون هذه المواجهة مواجهة مباشرة، تأخذ طابعاً صدامياً عنفياً عسكرياً، وتهدف إلى منع الدّين من تثبيت أركانه وأحكام أسسه؛ لكن ما أن تكون الغلبة للدّين وفئته على تلك القوى والجماعات، ويستطيع الدين أن يحكم بنيانه، ويثبت أركانه في معركة التّنزيل تلك؛ حتى يبدأ فصل جديد من فصول تلك المواجهة.
ولذلك عادة ما كان يطرح هذا السؤال، وهو: عندما ينتصر الدين ويُحكم أسسه وبنيانه، هل تنتهي المعركة وفصول المواجهة مع تلك القوى والجماعات المذكورة ومصالحها، أم إنّ فصلاً جديداً من فصول تلك المواجهة يبدأ؟
الجواب أن تلك المواجهة لا تنتهي عند حدّ غلبة الدّين في مرحلة التّنزيل، وإنّما يبدأ فصل جديد من فصول تلك المواجهة بين الدّين من جهة، وتلك القوى والجماعات من جهة أخرى. سوى أن طابع تلك المواجهة، وأساليبها، وأدواتها، وأهدافها المباشرة؛ كل ذلك يكون مختلفاً عمّا كان سائداً في مرحلة التّنزيل، وأساليبها، وأدواتها، وأهدافها المباشرة، حيث يمكن أن نطلق على هذه المعركة تسمية معركة التأويل، أي معركة تفسير الدين، وإنتاج دلالاته.
هنا في مرحلة التّأويل - أي تفسير الدّين وتأويل نصوصه وكتابه - تصبح تلك القوى والجماعات المخالفة للدّين وقواه، جزءاً من الاجتماع الدّيني العام، عندما تنخرط في هذا الاجتماع، كتدبير شكلي للحفاظ على مصالحها ووجودها، ولتغيير طريقة العمل لديها، من مواجهة مباشرة إلى مواجهة غير مباشرة، ومن مواجهة تأخذ طابعاً صداميّاً عنفيّاً، إلى مواجهة تأخذ طابعاً فكريّاً ثقافيّاً، من مواجهة تعتمد أدوات الحرب والقتال، إلى مواجهة تعتمد أدوات التّفسير والتّأويل، حيث يمس التّغيير أيضاً الهدف المباشر الذي تعمل عليه تلك القوى والجماعات، من إسقاط الدين برمّته، إلى العمل على ابتداع تفسير له، وإنتاج تأويل لنصوصه، يعيد تلك القوى ومشروعها إلى واجهة الصّدارة، ويحفظ لها مصالحها وأهدافها.
هنا تبدأ المواجهة الأخطر، عندما يُعمد إلى الإبقاء على ظاهر من الدّين، لكن يجري العبث إلى حدٍّ بعيد في مضمونه ومحتواه وقيمه. هنا يُعمل على استخدام الدّين كوسيلة، للحفاظ على مصالح تلك القوى والجماعات، عندما توظّف نصوص الدّين، أو يُعمل على كتمان حقائقه وتزييف معانيه لتحقيق أهدافها. هنا يجري العمل على قلب المفاهيم الدّينيّة، حيث يصبح ما هو أساسي في الدين - كالعدل والإصلاح - أمراً ثانويّاً، أو يمكن تجاوزه، وتصبح الأمور ذات البعد الاحتفالي مثلاً أمراً جوهريّاً في شكله و(طقسه)، كي يستخدم للتّلطي على فساد السلطة وانحرافها، وانقلابها على الدّين وقيمه الأساسية.
إنّ الخطورة في هذه المواجهة، لا تكمن فقط في أن تلك القوى والجماعات تواجه في الميدان نفسه (الإجتماع الدّيني)، أو أنّها تنافس بالأدوات نفسها (الدين ومشروعيّته)، ولا بالوسائل والأساليب نفسها (الفكر والثّقافة...)، ولا لمجرد أن تأويلها هذا ومضمونه قد ينطلي على كثيرين، لأنّها تقدمه بإسم الدّين، ولا لأنّها تملك القدرة على المواجهة من خلال توظيفها لأدوات المال والسّلطة... بل لأنّ تلك القوى والجماعات تعمل على هذا الهدف، وهو إنتاج تأويل للدين وتفسير له، سوف يُعتمد بعد برهة من الزّمن باعتبار كونه الدين نفسه، وأنّه ما أراده الله تعالى، وأنّه ما يجب العمل به لطاعة الله تعالى ورسوله(ص) والسير على نهجه وهداه.حيث يصبح والحال هذا المرجعية الدينية في التشريع والفكر وبناء الثقافة المجتمعية في مختلف مجالاتها.
هنا يصبح الدّين نقمة، وليس رحمة، باسم الدّين. وتصبح طاعة الله عدواناً، والعمل بهداه إجراماً. وتضحى العقيدة أنّ الله تعالى خلق الخلق ليقتلهم، وليعمل الذّبح فيهم، بإسم الدّين. هنا يصبح الفساد صلاحاً، والظّلم عدلاً، والتّعصّب فضيلة، والعنصرية كرامة، والتّخلّف هداية.
هنا إذا ما نجحت تلك القوى في تثبيت تأويلها للدّين على أنّه التّأويل الحقّ، فإنّ هذا الإنحراف لن يقف عند حدود تلك القوى وفئاتها، بل سوف يعمّ الإجتماع الدّيني بمجمله. ولن يقتصر على زمن إنتاج ذلك التأويل وعصره، بل سوف يعمّ الزّمن الديني كلّه إلى قيام السّاعة. حيث سوف يأتي أقوام، وتذهب أمم، لتعمل بذلك التّأويل، فترتكب الظّلم، والبغي، والفساد. وتخالف الدّين وقيمه. وتوغل عدواناً وإجراماً وتشويهاً للدّين، كلّ ذلك بإسم الدّين ورسالته.
إنّ ما نقدّمه ليس مجرّد تحليل، وإنّما هو واقع التّاريخ الدّيني كلّه، بما فيه الإسلامي. ولا أدل على ذلك من ظاهرة الوضع والتّحريف التي فشت في النّصّ الحديثي (أحاديث النّبي(ص)) والتي كان لها العديد من أسبابها والتي منها السياسيّة والمذهبية... وأيضاً ظاهرة الكذب على رسول الله(ص) والتي بدأت في حياته. فضلاً عن انخراط العديد من فقهاء السلاطين في ركاب السلطة ومشروعها المعرفي والثقافي، وابتداعهم لنصوص دينية، وأكثر من تفسير، عمل على تقديمه على أنّه البيان الحقّ، وتلقته الناس بالقبول والتّسليم([1]).
هي معركة التّأويل إذن، حيث نجحت قوى السّلطة والمال والجاهليّة في إنتاج تأويل هجين للدّين، تأويل أخذ من الدّين قدسيّته ومشروعيّته و(طقوسه)، ومن السّلطة عنفها واستبدادها وإقصائها، ومن الجاهليّة عصبيّتها وقسوتها ولا عقلانيّتها. فكان ذلك التّأويل وتراثه الدّيني نتيجة هذا الإندماج العجيب لتلك العناصر الآنفة الذكر.
إنّ ظاهرة التّكفير الذي نشهد، لم تكن فلتة من فلتات التّاريخ الدّيني، بل هي حصيلة أكثر من مخاض وصراع في ذلك التّاريخ وأحداثه وتحوّلاته، حيث استطاعت تلك القوى أن تعيد مشروعها ومفاهيمها وثقافتها إلى ساحة الفعل والحضور والتأثير، لكن هذه المرّة بغطاء ديني. وتمكّنت أن تنقلب على الدّين وجوهره، بإسم الدّين وبلباسه.
إن من يحلّل العناصر الفكريّة الأساسيّة التي تشكّل ظاهرة التّكفير الإجرامي (إلغاء، عصبيّة، إستبداد، عنف، إجرام، شكليّة دينيّة، قداسويّة...) يصل إلى هذه النّتيجة، أنّها نتاج ذلك التّأويل للدّين، الذي هو خليط من عناصر جاهليّة وسلطويّة ودينيّة، تأخذ من الدين ظاهره، وتدع جوهره. تعمل ب(طقوسه) وتنبذ قيمه. تستعير قدسيّته وتأتزر مشروعيته، لكّنها تجافي رحمته وإنسانيّته وحضاريّته ومعانيه الأخلاقيّة السامية.
إنّ نجاح تلك القوى ومشروعها في إعادة التّموضع في الإجتماع الإسلامي، قد أدّى إلى إيجاد ديناميّة مستديمة لإنتاج العنف والإجرام والإنقسام والإختلاف في الإجتماع الإسلامي، كلّما توّفرت الشروط والظروف المناسبة، لتسييل ذلك التّأويل ومفاعيله.
لعل هذه المقاربة تضيء على النّشأة التّاريخيّة، والأسباب والعوامل، التي أنتجت لاهوت التّكفير. وكيف استطاع - بإسهام من السلطة - أن يصبح جزءاً أساسياً من التّراث الدّيني، ومصادر المعرفة والسلوك والتّشريع لديه... وهي أيضاً مقاربة تسعى إلى تشخيص مكمن الخلل، لتشيرإلى المنابع التي تنتج ظاهرة التّكفير الإجرامي ومفاعيلها وجميع أزماتها.
لكنّ المشكلة أن هذا التّراث التّكفيري قد تمذّهب وتحوّل إلى ثقافة مجتمعات بأسرها. وهي تملك الكثير من نفوذ السّلطة وسطوة المال. وتملك من قدسيّة الدّين ومشروعيّته، ما يجعل من دعوتها وأفكارها مادة سهلة النّفوذ إلى نفوس الكثيرين، عندما توظّف لغة الدّين ونصوصه وتستغلّ العاطفة الدّينيّة لممارسة الإستقطاب والدّعوة والتّجنيد.
المشكلة الآن أنّ هذا التّراث التّكفيري قد أصبح ظاهرة معقّدة ومنتشرة. له رجاله، ودعاته، ومساجده، وجامعاته، ومدارسه، ومصادر تمويله، ومنابره الإعلاميّة، ووسائل إعلامه، وتنظيماته، وأحزابه، وجمعيّاته. بل وأنظمة سياسية تتبنّى فكره وثقافته، وإن تبرّأت من بعض أفعاله. ودعماً إقليميّاً ودوليّاً، عندما يصبح التّكفير أداة في ساحة الإحتراب الدولي والإقليمي.
إنّ ما تقدّم قد يوصل إلى هذه النّتيجة أنّه إذا كانت ظاهرة التّكفير ظاهرة مركّبة لها أبعادها الفكريّة والدّينيّة والثّقافيّة والإعلاميّة والماليّة والإجتماعيّة والسياسيّة... فإن مواجهتها يجب أن تكون مواجهة شاملة، تأخذ بعين الإعتبار كافة الأبعاد التي ذكرنا، ولا تقتصر على البعد الأمني أو العسكري.
وقبل كلّ شيء ينبغي توفّر الإرادة الصّادقة، وشجاعة الموقف، التي لا يحول بينها وبين تحمّل مسؤوليّتها أي عامل سياسي أو مصلحة اقتصادية أو سوى ذلك. كما ينبغي الكف عن استخدام وتوظيف هذه الظّاهرة في أي صراع دولي أو إقليمي، لتحقيق أهداف ومصالح، لكنّها قد تؤدّي إلى تحويل التكفير إلى وحش إجرامي يفتك بالمجتمعات وأمنها، كما حصل ويحصل في مجتمعاتنا وبلداننا.
إنّ مواجهة هذه الظّاهرة تحتاج إلى مشروع شامل وجذري، وإمكانيّات كبيرة، وتعاون الكثير من القوى، وتسمية الأشياء بأسمائها، لأن المديات الّتي وصلت إليها هذه الظّاهرة حاليّا، هي مديات غير مسبوقة في التّاريخ الإسلامي، بل والدّيني أيضا. وهي تزداد انتشاراً واتّساعاً يوماً بعد يوم. وباتت أخطارها تهدّد العديد من المجتمعات وأمنها وجميع أوجه الحياة لديها. وهذا ما يتطلّب عدم المداهنة في تشخيص الأسباب الأساسية الكامنة خلفها، وخاصة ما يرتبط منها بالجانب الأيديولوجي والديني والثقافي.. ومنبعه ومؤسساته، بل ومجمل المنظومة التي تنتمي إليه، وتدعمه وتعمل على الترويج له، والدعوة إليه، حتى لو كانت أنظمة تتلطى بالدين، وتلتحف رداءه.
ثانياً: ظاهرة التكفير؛ النظريات المفسّرة:
إنّ من أشدّ ما تعاني منها مجتمعاتنا وأمّتنا في هذا العصر، هو تلك الظّاهرة من التّكفير، التي تعبّر عن نفسها بأساليب وحشيّة وإجراميّة، وتلبس لباس الدّين، وتتحدّث لغته. وهي ظاهرة ليست طارئة في الإجتماع الإسلامي، بل لها أرهاصاتها وامتداداتها، التي تعود بها إلى بدايات التّاريخ الإسلامي، سوى أنّها تتمظهر في كلّ عصر بمظاهر وقوالب مختلفة.
وهي ظاهرة تمتلك الآن منهجها، ومدرستها الفكريّة، وخطابها، وتراثها، ومؤسّساتها الإعلاميّة والتّعليميّة والدّينيّة، وجامعاتها، ومواردها الإقتصاديّة، وإمكانيّاتها البشريّة، وانتشارها الجغرافي والثّقافي، وأضحت تمثّل تهديداً للعديد من المجتمعات العربيّة والإسلامية، بل تتعالى أصوات تعتبرها تهديداً للأمن العالمي.
ورغم وضوح هذه الظّاهرة في حاضرها وتمظهرها، إلّا أنّ الإختلاف حاصل في تفسير الأسباب الجوهريّة، التي تؤدّي إلى انبعاثها بين فترة وأخرى؛ فما هي أهمّ الآراء أو النّظريّات، التي تفسّر السّبب، أو الأسباب الجوهريّة لهذه الظّاهرة، وانبعاثها بين الفينة والأخرى؟
هنا سوف نحاول عرض وتحليل أهمّ تلك الآراء والنّظريّات، التي حاولت تقديم الإجابة على هذا السؤال، لنخلص إلى ما نعتقده أصحّ تلك النّظريّات:
- نظريّة الأسباب الخارجيّة: وقد أدرجتها كنظريّة أولى، لا لأهميّتها، بل لأنّها آخر ما طرح في هذا الشان، إن لم أقل من أغرب ما طرح، حيث أنّها تعفي تاريخنا وثقافتنا ومجتمعاتنا وأنفسنا من أيّة مسؤوليّة، وتلقي باللائمة على الآخرين، وتحيل أسباب الظّاهرة إلى أسباب خارجيّة سياسيّة، تتمثّل بالتّقصير الأميركي والغربي عن مواجهة التّمدّد العسكري والجغرافي لبعض تلك الجماعات التّكفيريّة (كما حصل في العراق مع داعش)، لتقدّم رؤية، تفيد بأن المعسكر الأميركي الغربي كان قاصداً لهذا الأمر لأسباب داخليّة أميركيّة، أو ربّما بهدف تعزيز الإسلاموفوبيا، ولتنشيط سوق السلاح لديه، وتحقيق مصالح إقليميّة ودوليّة مختلفة...
في مقام النقد، يمكن القول إنّ هذه النّظريّة وإن كانت صحيحة في جانبٍ منها، لكنها قاصرة عن تقديم تفسير علمي وموضوعي لتلك الظّاهرة، أولاً: لأنّها لا تميّز بين الأسباب الجوهريّة والعوامل المساعدة، فما ذكر، قد يكون مجرّد عامل من العوامل المساعدة في ظرف ما، لا أكثر. ثانياً: محلّ النّقاش هو في تفسير أصل نشوء هذه الظّاهرة، وليس في تفسير تمدّدها الجغرافي والعسكري في هذه المنطقة أو تلك. ثالثاً: لا تقدم هذه النّظريّة تفسيراً لوجود تلك الظّاهرة بقوّة في مجتمعات وبلدان، لا يوجد فيها ذلك الدّور العسكري الغربي والأميركي المباشر والجوهري. رابعاً: ماذا عن وجود هذه الظّاهرة في تاريخنا العربي والإسلامي، حيث لم يكن ذاك الدّور الغربي والأميركي. خامساً: إنّ العمل دائماً على تبرئة الذّات، قد ينطوي على حال من النّرجسيّة الإجتماعيّة والتّاريخيّة والثّقافيّة، التي تعطّل لدينا كلّ أدوات النّقد، والقدرة على اكتشاف الخلل لدينا، فضلاً عن علاجه واستئصاله.
وطالما أنّنا نمارس تعمية على الأسباب الحقيقيّة الكامنة خلف تلك الظّاهرة، فهذا يعني القبول بمفاعيلها والمنع من التّأسيس لأي عمل يسهم في تعطيل نتائجها الموغلة في تدمير مجتمعاتنا وإنساننا ومختلف أوجه حياتنا الإجتماعيّة.
هنا لا نريد في المقابل تبرئة الدّور الغربي والأميركي في توظيف تلك الظّاهرة ومحاولة الإستفادة منها لتحقيق مصالحه، فهذا شأنهم وديدنهم، لكن مورد البحث هو في تلك الأسباب الكامنة فينا، والتي تسمح للغربي والأميركي أن يستفيد من مكامن الخلل لدينا؟
- نظريّة التّفسير الإجتماعي: حيث تذهب هذه النّظريّة إلى القول بأنّ أسباباً كالفقر، والبطالة، والتّهميش، والإستبداد، وعدم المشاركة... قد تدفع العديد من المجتمعات وجماعاتها وأفرادها إلى اللّجوء إلى تلك الظّاهرة، والإنتماء إليها.
وفي مقام مناقشة هذه النّظريّة، ينبغي القول:
أوّلاً: نحن لا نقلّل من الآثار السّلبيّة التي تترتّب على تلك العوامل الإجتماعيّة، لكنّها لا ترقى إلى أن تكون أسباباً جوهريّة لها، حيث إنّه يمكن أن تحصل تلك الظّاهرة لو لم تتوفّر تلك العوامل أو بعضها، لكنّها لا يمكن أن تحصل فيما لو انتفت أسبابها الحقيقيّة والجوهريّة، وهذا الفرق بين السّبب والعامل.
ثانياً: نلاحظ أنّ العديد ممّن ينخرط في تلك الظّاهرة، لا يأتي من مجتمعات تعاني من مجمل تلك العوامل الإجتماعيّة، فهو لم يصبح تكفيريّاً بسبب الفقر، لاْنه لم يكن فقيراً بالأساس، أو لم ينخرط في تلك الظّاهرة بسبب التّهميش، لأنّه كان يعيش في مجتمعات تنعم بمستوى جيد من المشاركة الإجتماعيّة أو السياسيّة...
ثالثاً: لو فرضنا أنّ تلك العوامل الاجتماعيّة، ترقى إلى أن تكون أسباباً جوهريّة لإنتاج ظاهرة التّكفير العنفي، فسوف تكون النّتيجة أنّ دولاً فقيرة، كبنغلادش وغيرها، يجب أن تكون المصدر الأساسي، والحاضن الأهمّ لهذه الظّاهرة ومظاهرها. لكنّنا نجد خلاف ذلك، إذ أنّ هذه الظّاهرة أكثر ما تنتعش وتنتشر في مجتمعات وبلدان، تتميّز بأمور وخصائص، تختلف عمّا هو موجود لدى تلك الدّول والمجتمعات الإسلامية الفقيرة والمهمّشة، فهذه البلدان تملك ثروات نفطيّة هائلة، ومستوى عالٍ من الدّخل القومي، ومستوى جيّد من التّقديمات الإجتماعيّة والصحيّة والتّعليميّة... التي توفّرها تلك الأنظمة الحاكمة في تلك البلدان، كنوعٍ من التّعاقد الإجتماعي، الذي يقوم على القبول بالنّظام السّياسي القائم، مقابل مستوى عال من الريع المالي والاقتصادي والاجتماعي، لكن ما يميّز تلك المجتمعات، هو ذلك المنسوب العالي من الأدلجة، التي تتّصف بالتّكفير، والتّعصب، والإلغاء، والتّحريض على العنف والقتل، وممارسة التّوحّش.
- التّفسير الأيديولوجي: وتذهب هذه النّظريّة إلى القول، بأنّ السّبب الجوهري الكامن خلف هذه الظّاهرة، هو تلك التّربية الأيديولوجيّة، وذلك التّأويل الإلغائي والعنفي للدّين، والذي تشكل على مدى اكثر من ألف عام، بفعل رغبة السلطان بإنتاج تأويل للدّين يخدم مصالحه، وتواطؤ فئة من فقهاء البلاط، فكان تراث التّكفير، على شبه من عنف السّلطان وتوحّشه من جهة، وشبه من عنصريّة فقهاء البلاط وتكفيرهم من جهة أخرى... وهذا التّراث هو البذرة التي تستولد تلك الظّاهرة، والتي ما إن تتوفّر لها العوامل المساعدة لنموّها وانتشارها، فإنّها تفعل وتعبّر عن نفسها بأسوأ ما فيها، لكن السّبب الأساس إنّما يكمن في تراث التّكفير ذاك، ولاهوت التّوحّش لديه، وذلك التّأويل العنفي للدّين ونصّه وكتابه؛ وكلّ ما يحكى في المقابل عن عوامل إجتماعيّة، أو سياسيّة، أو خارجيّة، أو توظيف إقليمي أو غربي أو أميركي... إنّما هو مجرّد عوامل، بغضّ النّظر عن درجة أهميّتها وخطورتها، ومدى تأثيرها في المساعدة على نمو هذه الظّاهرة، وولادتها، وانتشارها، وتمكّنها، ووصولها إلى تلك المديات غير المسبوقة.
وما يشهد على هذا التّفسير، أنّ القاسم المشترك لدى جميع تلك الجماعات المنخرطة في هذه الظّاهرة، هو ذلك البعد الأيديولوجي الكامن في السّلفيّة الوهّابيّة بشكلٍ أساس، وأنّ الخطاب الذي تعتمده تلك الجماعات، يدلّ على أنّ مرجعيّتها الفقهيّة والفكريّة، إنّما تكمن في ذلك التّراث السّلفي الوهّابي، وأيديولوجيّته ذات المضمون العنفي والتّكفيري، وأنّ جغرافيّة انتشار هذه الظّاهرة هي نفسها جغرافيّة انتشار تلك السّلفيّة، وأنّه لا يوجد مجتمع وصلت إليه تلك السلفيّة، إلّا وأنتج ذلك النّوع من التّكفير العنفي والإجرامي([2]).
وإنّ مجمل ما ذكر من عوامل -على خطورتها- قد تتوفّر في مجتمع أو آخر، لكنّها لا تنتج لوحدها، وبمعزل عن ذلك البعد الأيديولوجي شيئاً من تلك الظّاهرة أو إفرازاتها، في الوقت الذي ما إن يتوفّر فيه ذلك السّبب الأيديولوجي، إلّا ويتوقّع فيه إلى حدٍّ بعيد إنتاج تلك الظّاهرة، أو شيء منها، وإن لم يتوفّر- في المقابل- كلّ أو جل تلك العوامل المذكورة.
بناءً على ما تقدّم، وإذا كان تقديم أيّ مشروع علاجي لتلك الظّاهرة يتوقّف على التّشخيص العلمي والصّحيح لأسبابها؛ فيمكن القول، إنّ أيّ فعل علاجي يجب أن يتوجّه بشكلٍ أساس إلى السّبب الرّئيسي، وهو ذلك التّراث التّكفيري، والتّأويل العنفي للدّين، ولاهوت التّوحّش لمعانيه، والذي يعبّر عن نفسه في التّربية الدّينيّة، ومناهج التّعليم في المدارس والجامعات، وفي الخطاب الإعلامي في مختلف وسائل الإعلام، وفي الثّقافة الدّينيّة، التي يعمل على نشرها من خلال المساجد، والمنشورات، ومختلف المواقع الإلكترونيّة، ووسائل التّواصل الإجتماعي...
وعليه، ينبغي العمل على تطهير التّراث الدّيني من مدخولات التّكفير العنفي، من خلال القيام بمشروع نقدي، يعمل على تفكيك جميع حلقات ذلك التّراث، وإبطال قدرتها على الفعل والتأثير، ومن ثمّ تنقية جميع مناهج التّعليم والمنشورات من مضامين ذلك التّراث، وتعطيل مختلف الوسائل الإعلاميّة، التي تبثّ سموم ذلك التّراث، وتمارس التّحريض والعنصريّة، وتدعو إلى ممارسة العنف المتوحّش، والإلغاء والتّكفير... ومن ثمّ يؤتى إلى تلك العوامل للعمل عليها، وخصوصاً الامتناع عن توظيف أداة التّكفير العنفي في أيّ صراع إقليمي أو دولي أو سياسي أو... فضلاً عن بقيّة العوامل، التي لا شكّ أنّها عوامل مساعدة ومؤثّرة في إنتاج تلك الظّاهرة، وغيرها من الظّواهر المرضيّة في مجتمعاتنا، لكن يبقى قبل كلّ شيء، أن يُعمل على إنتاج وتعزيز ذلك التّأويل (أو التّفسير) الدّيني، ذي المضمون الحضاري، والانساني، والقيمي، والمعتدل، والنّهضوي، والذي يُقصي كلّ معاني العصبيّة والجاهليّة، وكلّ مضامين التّخلّف، التي ألبست لباس الدّين، وتوّجت تاج القداسة، والتي لا يمكن لأيّ مشروع حضاري إسلامي أن ينهض، ويحقّق أهدافه، ما لم يعمل على استبعادها، وإلغائها من التّربية، والتّعليم، والثّقافة، والإعلام، والتّراث إن استطعنا إلى ذلك سبيلاً.
وهنا نجد من المفيد الإشارة الى بعض تلك المقولات التي يحاول العقل التكفيري أن يستفيد منها، من أجل إنتاج دينامية تكفير بحقّ بعض المجتمعات الإسلامية، وكيف يمكن أن نواجه هذه المقولات من خلال تشريح واحدة منها والردّ عليها.
حيث يتم التداول في مناخ التكفير الحالي في مقولات عديدة، تقدّم على أنها من أسباب التطرف أو التأزّم الحاصل في العلاقات الإسلامية الإسلامية، حيث يجري البحث في الكثير من القضايا ذات الصلة بها.
وبما أن أكثر من مقاربة لبعض تلك المقولات قد توصل إلى غير المراد منها، فينبعي الوقوف عندها ومحاولة تشريحها، بما يمكن أن يؤدي إلى تغيير طريقة تلك المقاربة، وبالتالي تجنّب مجمل النتائج التي قد تترتّب عليها.
واحدة من تلك المقولات، مقولة سبّ الصحابة وشتمهم، والتي عادة ما تنسب إلى المسلمين الشيعة، ليتمّ تحميلهم أكثر من مسؤولية فيما يرتبط بمناخ التطرّف والتكفير الحاصل ومترتباته، بل ليذهب أتباع المنهج التكفيري إلى أبعد من ذلك، عندما يعمدون إلى استثمار تلك المقولة كرافد لتبرير مجمل ما يقومون به من أعمال إجرامية وقتل وسوى ذلك.
وحتى لا تتحوّل هذه المقولة، إلى مسلّمة يبني عليها أتباع ذلك المنهج مواقفهم، ويتخذونها ذريعة إلى أفعالهم، نجد من المجدي مناقشة هذه المقولة فيما يلي من نقاط:
- يوجد تحريم فقهي ديني صدر من كبار مراجع الدين للمسلمين الشيعة، يمنع أية إساءة لأي من المقدسات أو الرموز الدينية للمسلمين السّنة، بما فيهم شتم الصحابة، هذا فضلاً عن تحريم أي عمل يؤدي إلى الأضرار بقيم الأخوة بين المسلمين، أو يسيء إلى الوحدة الإسلامية، ويساعد على إيقاع الفتنة في صفوفهم، وتخريب العلاقات فيما بينهم([3]).
- يجب التفريق بين أمرين، الأول وهو الشتم والسب، والثاني وهو التخطئة والنقد لمجمل ما حصل في التاريخ الاسلامي، الأول بما هو لغة وضيعة وتعبير يتجاوز القيم الأخلاقية، والثاني بما ينبغي أن يتحلّى به من موضوعية ولغة علمية؛ وحتى هذا قد يجب الإمساك عنه، عندما يصبح مدخلاً للفتنة، وسبباً لتسعير العصبيات المذهبية والطائفية.
- إن حصول بعض الإساءات من قبل بعض الأفراد أو المجموعات، لا يعني وجود قبول فقهي أو مجتمعي عام بها، بل إن هذا المجتمع أو ذاك كأي مجتمع، فيه من العوام أو السفهاء الذين يرتكبون السفاهات والإساءات، وهم بذلك يخالفون الموقف الفقهي والتوّجه المجتمعي الموجود لدى المسلمين الشيعة وفقهائهم.
- لا يصح الحديث عن ظاهرة مجتمعية موجودة لدى المسلمين الشيعة، تمارس هذه الإساءة أو تلك، لكن للأسف عندما يستعر المناخ المذهبي، وتوّفر بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، إمكانية أن يأخذ الشارع دوره في بعض عوامه أو سفهائه، فقد يحصل أن قد يظنّ البعض وجود هكذا ظاهرة، وليس الأمر كذلك.
- لن يكون من الصحيح تحميل المسلمين الشيعة تلك الإساءات التي تحصل من بعض العوام أو السفهاء، كما هو الحال لدى أيّ من الطوائف أو المذاهب الأخرى، عندما تصدر أية إساءة من سفهائهم أو عوامهم تجاه أيّ من مقدسات الآخرين، فعندها يجب أن تُحمل لمن قام بها، وليس لطائفته أو مذهبه.
- ينبغي العمل على بلورة رؤية شاملة تعالج مجمل موارد الخلل في العلاقات الإسلامية الإسلامية، وتقديم العلاجات المناسبة لها، بما فيها تقديم ثقافة دينية ومجتمعية تقوم على عدم الإساءة إلى أي من مقدسات أو رموز الطوائف والمذاهب الأخرى، وعلاج كل الأسباب التي تحض على ممارسة الإساءة الدينية والمذهبية، بل ينبغي العمل على تجريم تلك الإساءات، خصوصاً عندما تصبح مدخلاً للفتنة وتسعير العصبيات المذهبية.
- إنّ من الخطأ التعامل مع هذه الإساءات، بطريقة تسمح بتقديم المبرّرات لأصحاب المنهج التكفيري، لارتكاب الجرائم وأعمال القتل والذبح والتفجير، وممارسة مختلف ألوان الإرهاب والتطرّف، عندما يتمّ تحميل تلك الإساءات لطائفة بأكملها، أو يُعمل على الترويج لها بطريقة غرائزية، تستنفر العصبيات المذهبية وشهوة القتل والاجرام.
- قد نحتاج إلى كثير من التعقل والحكمة في التعامل مع هكذا حالات، حتى لا ينجر العقلاء إلى ساحة السفهاء، وحتى لا نسمح لهذه الأفعال المسيئة بأن تستغل لتعكير صفو العلاقات الإسلامية الإسلامية، عندما يُعمل على تضخيمها أو إثارتها بطريقة خاطئة، أو استغلالها في ممارسة التشويه أو الإساءات المقابلة.
- قد يكون من المجدي في تعزيز العلاقات الإسلامية الإسلامية، العمل على التركيز على النقاط الإيجابية والمواقف البنّاءة، التي تصدر من أيّ من أتباع المذاهب تجاه المذاهب الأخرى، لأن في ذلك تنمية لمناخ الثقة والتواصل والحوار، بل قد يسهم ذلك في حصار جميع تلك الحالات السلبية على مستوى العلاقة فيما بين المسلمين وطوائفهم.
- قد نحتاج إلى إعادة بناء ثقافتنا الدينية والمجتمعية، بما ينزع نحو الانشداد إلى القضايا الحضارية الكبرى والتحديات التي تواجه الأمة، بما فيها مواجهة الاحتلال والاستعمار والحروب الناعمة التي تُشنّ علينا، وعلاج مشاكلنا وأزماتنا الحياتية والمدنية، وعدم الانجراف إلى كثير من القضايا، التي قد يحرف الانشغال فيها عن تلك القضايا والتحدّيات، ومعالجة الأمور التي قد تخدم واقع الناس ومتطلّباتهم.
وهنا لا بدّ من القول إنّا لم نرد فيما سطّرناه تقديم مرافعة مذهبية، بمقدار ما هو محاولة لتقديم رؤية ومنهج للتعامل مع العديد من القضايا ذات الصلة بالعلاقات البينية على مستوى الاجتماع الاسلامي المذهبي وغيره، بما يمكن أن تخدم في تجنب ثقافة الفتنة والعصبية المذهبية، وتعمل على تعزيز ثقافة الحوار والتسامح والعيش المشترك.
ثالثاً: الحركات التكفيرية وقابلية التوظيف:
واحدة من أهمّ ميّزات الحركات التّكفيريّة، قابليّتها للتّوظيف، من قبل أكثر من جهة دوليّة أو غير دوليّة، وبطريقة تتنافى مع مصالح الأمّة الإسلامية، وجميع قضايا المسلمين. وسواءً علمت تلك الحركات بذلك أم لم تعلم، وسواء تعدّدت وسائط التّوظيف أم لم يحصل، فإنّ الكثير من سياسات تلك الحركات وبرامجها، يسهم في تدمير المجتمعات الإسلامية والإضرار بمصالحها، في الوقت الذي تخدم فيه تلك السّياسات والأعمال الإجراميّة والإرهابيّة مصالح قوى دوليّة، ومصالح الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وأهدافه.
وعليه، سوف يكون السّؤال مشروعاً، حول الأسباب التي تجعل من تلك الحركات التّكفيريّة ظهراً مناسباً للامتطاء، وأداة سهلة التّوظيف في مشاريع القوى الإستعماريّة ومصالح الكيان الإسرائيلي؟
إنّ أهم الأسباب التي يمكن أن تذكر في هذا المورد هي ما يلي:
- إنّ تلك الحركات تعتاش على ذلك التّراث، الذي تشكّل نتيجة انخراط جملة من الفقهاء في كنف السّلطة وجهازها المعرفي، ولذلك فهي تحمل جميع تشوّهات ذلك التّراث وعوراته، حيث إنّ رؤيتها للعالم والواقع من حولها، سوف تكون موغلة في الماضوية، ومنفصمة عن الواقع، ومشبعة بعيون ذلك التّراث ومعاييره.
- إنّها تعمل على اجترار أزمات التّاريخ واصطفافاته، لتمارس إسقاطاً متعسّفاً على الواقع الذي تعيش، لتحاول تشكيل هذا الواقع على ضوء رؤيتها للماضي وإشكاليّاته؛ محاولة تختزن مجمل سمات الإستنساخ المتصلّب لذلك التّاريخ وقضاياه، من دون أن يكون لديها أدنى قدرة على إيجاد ذلك التّوازن بين الماضي والحاضر.
- تفتقد إلى القدرة على رؤية الواقع بشكل علمي وموضوعي وصحيح، والسبب في ذلك، أنّه يعوزها المنهج، والأدوات العلميّة والمعرفيّة، والشّروط الموضوعيّة، التي تسعفها على ذاك العمل، بما في ذلك منظومة التّجربة ودورها، والمنهج التّجريبي الذي يتجاوز بمفهومه وسعته الإطار التّطبيقي، إلى الإطار الإنساني والإجتماعي الأوسع. ومن هنا فهي تفتقر إلى تلك الإمكانيّة لتحديد الأهداف، والسّياسات، والأولويّات، ومعرفة العدو من الصّديق، والعمل في ساحات متشابكة وغاية في التّعقيد.
- تعاني تلك الحركات من ضعف دور العقل والعقلانيّة في رؤيتها للواقع، والماضي، وذلك التّراث. والسّبب أن بنيتها الفكريّة والثّقافيّة، لا تحتمل ذلك الدّور الفعّال للعقل والعقلانيّة في القراءة والنّقد والتّحليل والمقارنة... وإنّما تعاني اندمالاً مفرطاً في ماضويتها وسلفيتها، واستغراقاً منقطع النّظير في مفاهيم ذلك التّراث المشوّه، ممّا قلّص إلى حد العدم ذلك الدّور المنتظر للعقل في فهمه للواقع وإدراكه، ونقده للتّراث وغربلته، وتالياً العمل على عقلنة التّراث، بدل أن نقع في ترثنة العقل.
- بناءً على ما ذكر آنفاً، يمكن القول، إن تلك الحركات التّكفيريّة لا تمتلك الإستعداد الفكري والثّقافي لتطور حداثوي فعّال ومستديم، في مختلف مجالات الإجتماع العام، وإدارته وتنميته. ولذلك هي تستطيع السّيطرة (بالمفهوم العسكري) وممارسة سلطة التّغلّب في أكثر من بقعة جغرافيّة، ولكنّها لا تقوى على التّنمية، ولا تستطيع حسن الإدارة، ولا تهتدي إلى تلمّس صحيح وعلمي لمختلف المشاكل الإجتماعيّة والإقتصاديّة والتّنمويّة والبيئيّة... فضلاً عن القدرة على حلّها. ولذا هي تصلح لهدم الدّول وليس لتطويرها. وهي توظّف لتدمير المجتمعات وليس لبنائها وتحديثها، أو الأخذ بجميع أسباب التّطوّر والحداثة.
- تورم البعد العنصري والعصبوي في ثقافتها ونظرتها للواقع وفئاته. فهي تحمل في أحشاء تلك الثّقافة مجمل أحقاد الماضي، ومشاعره العنصريّة، تجاه من اختلف ويختلف معها، في الدّين أو المذهب وغيره... وهي ما زالت تستفرغ من بطون ذلك التّراث المشوّه جميع ما اختزنه من أزمات وعصبيّات وكراهية، لتعمل على تمثّله والتّماهي معه، بمعزل عن حيثيّات الواقع واعتبارات الحاضر، ولتبني مجمل مواقفها وسياساتها ورؤيتها، من خلال ذلك المخزون العنصري وأحقاده، ومشاعر الكراهيّة لديه.
- ضمور البعد القيمي والإنساني في أيديولوجيّة تلك الحركات وثقافتها. والسّبب أنّها تستقي تلك الثّقافة من تراثٍ يعاني - بالإضافة إلى تشوّهاته - إلتواءات منهجيّة حادّة في تشكّله وصيرورته. لأنّه جاء في معظم صفحاته وصحائفه تعبيراً عن فقهاء السّلطان وثقافة السّلطة، أكثر منه تعبيراً عن معاني الدّين ومقاصده السّامية.
واحدة من تلك الإلتواءات تضخّم الجانب القانوني (الشّريعة)، بمعزل عن الجانب القيمي والإنساني في النّصّ الدّيني وحضوره. والاحتباس في نص فقهي، تشكل في جانب منه بناء على مصالح السلطان وميوله، فجاء تعبيراً عن عنف السلطة وتغوّلها. والأخطر من ذلك أنّه جعل من نفسه مرجعية متقدمة على أيّة مرجعية أخرى.حيث أصبح تراث السلطان في عنفه واستبداده وانحرافاته هو الأساس الذي تأوّل من خلاله جميع النصوص الأخرى.
وعليه، أتت ثقافة هؤلاء ثقافة جافّة قاسية، تعاني ذلك القحط في بعدها القيمي والإنساني، وهو ما انعكس على رؤيتها وعقلها وسياساتها وسلوكيّاتها، التي تجنح دائماً إلى القسوة والإجرام، وتتّصف بانعدام الشّعور الإنساني لديها.
8-تلاشي دور النّصّ الدّيني لصالح التّراث السّلفي. بمعنى أنّ الذي أصبح المعيار هو هذا التّراث وليس ذاك النّصّ. حيث غدا دور النّصّ تبرير ذلك التّراث وإعطاءه المشروعيّة بما له وعليه، بدل أن يكون دوره تطهير ذلك التّراث مما أصابه وعلق فيه. وأصبح يُنظر إلى النّصّ بعيون ذلك التّراث، ولم يعد يُنظر إلى التّراث بعيون ذلك النّصّ.
ولذلك عُمل على تطويع دلالات النّصّ، لتخدم تشوّهات التّراث. بدل الاستفادة من تلك الدّلالات، لاستئصال ما علق بالتّراث من تشوّهات، وأصابه من عوج. واستخدم النّصّ لإعطاء مشروعيّة دّينيّة لما أفسدته السّلطة، وأحدثه فقهاء السلطان، من إرثٍ أُسقط على ذلك النّصّ ونسب إليه، بدل أن يخالف نص السلطة، ويفضح تراث فقهاء السلاطين وعوراته. إنّ إقصاء النّصّ الدّيني بدلالاته الصّافية، قد أدّى إلى حرمان تلك الحركات التّكفيريّة من القدرة على الإستقالة من ألغام التّراث وتشوّهاته، وأكثر من تلوّث تاريخي ألقي فيه.
إنّ النّتيجة من كلّ ما تقدّم، أنّ تلك الحركات التّكفيريّة، قد أضحت أداة طيّعة، وسهلة التّوظيف، لأهداف وسياسات إستعماريّة، وتوسّعيّة، وإمبراطوريّة، تقوم بها جهات دوليّة وغير دوليّة، ترى في تلك الحركات، أنّها الأداة الأفضل لتحقيق ما ترتأي، ولو تم التوسل الى ذلك بوسائط إسلاميّة أو عربيّة، ومن خلال إستغلال العامل المذهبي، وتعزيز حالة العداء والخوف وانعدام الثّقة بين الطّوائف والمذاهب والجماعات المختلفة، ومن خلال اللعب على التّناقضات والاختلافات القائمة في مجتمعاتنا. ومع كلّ هذا، من خلال التشغيل الهدام لتلك الحركات وسهولته، نتيجة لتلك المثالب التي تعانيها في بنيتها الفكريّة والثّقافيّة والمنهجية، وفهمها المشوّه للدّين، وعقلها السّياسي، والدّور الوظيفي الذي تقوم به.
الخاتمة:
يمكن القول إنّ ملخص ما سطرنا في هذا البحث، يتلخّص في إنّ النظرية التي تصلح لتفسير ظاهرة التكفير العدواني هي تلك النظرية التي تحيل الظاهرة الى سبب أيديولوجي، يتمثّل في ذلك التراث التكفيري المستودع في بطون التراث، والذي تشكّل طيلة ظاهرة عقود متطاولة من الزمن، و إن كانت جذوره تمتدّ إلى ذلك التأويل السلطاني للدّين، حيث عُمل على إنتاج ذاك التأويل لخدمة مشروع السلطة وأهدافها، للنيل من خصومها، والقضاء على جميع من يعارضها، فكان لاهوت التكفير الإجرامي على شبهٍ من تلك السلطة في عنفها واستبدادها وعنصريتها وإقصائها وجميع مثاليها.
أمّا بقية النظريات من اجتماعية أو اقتصادية أو سوى ذلك، فليست إلا عوامل تؤدي إلى تهيئة بيئة مساعدة على أن يأخذ ذلك السبب الأيديولوجي مداه في ممارسة العدوان والإجرام و العنف.
و إنّ من يحلّل مكوّنات العقل التكفيري ذاك من العنصرية والماضوية واللاعلمية والانفصام عن الواقع و ...؛ يدرك لماذا يسهل توظيف ظاهرة التكفير تلك والحركات التكفيرية لخدمة مشاريع الاستعمار وقوى الاحتلال والاستكبار المعادية لجميع قوى المقاومة والاستقلال والإنسانية و العدالة.
و هذا يقود الى النتائج التالية:
1- إنّ القضاء على هذه الظاهرة يتطلب العمل على نقد وتفكيك ذلك التراث التكفيري، وإبطال مفعوله.
2- إنّ معالجة الظاهرة تلك هي معالجة أيديولوجية بالدرجة الاولى، وثقافية وتربوية بالدرجة الثانية، و من ثمّ اجتماعية و اقتصادية...
3- إنّ أيّ انتصار عسكري على تلك الظاهرة لا يعني القضاء عليها جذرياً، ما لم يُعمل على الانتصار عليها أيديولوجياً و ثقافياً و تربوياً...
4- إنّ المعركة العسكرية مع ظاهرة التكفير وحركاته هو بمثابة الجهاد الأصغر، أمّا المعركة الأيديولوجية فهي بمثابة الجهاد الأكبر. و هذا يعني أنّ تلك المعركة مع التكفير هي معركة طويلة، و تحتاج الى جهود كبيرة، و الى تعاون شامل، و خطط مدروسة للوصول بها إلى خواتيمها.
[1]- راجع: شقير محمد، الإصلاح الديني في ثورة الحسين(ع)، بيروت، دار المودّة، 2016م، ط2، صص 97-137.
[2]- شقير محمد، إشكاليات التكفير والمذهبية والرافضة، بيروت، دار المودّة، 2016م، صص16-58.
[3]- أفتى الإمام الخامنئي في هذا الموضوع بحرمة النيل من رموز أهل السنّة، أو القيام بأيّ فعل يؤدّي الى الفرقة والانقسام بين المسلمين. وهذه الفتاوى موجودة في الكثير من المواقع الالكترونية. أنظر مثلاً:www.yahosein.com //https:
عدد قراءات المقال : 2761
تعليقات الزوار
جديد الموقع
الإعلان