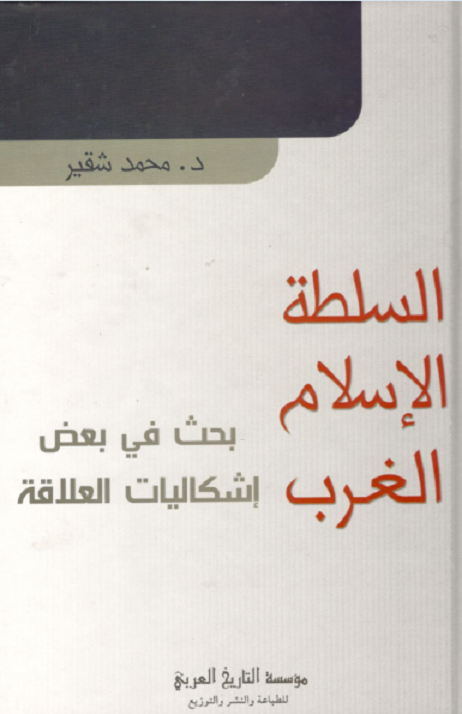في فلسفة العدالة والانسداد الحضاري

في فلسفة العدالة والانسداد الحضاري، هل من طريق ثالث...؟
مع انهيار الاتّحاد السوفياتي سادت مقولة نهاية التّاريخ، والتي أرادت القول إنّ الرأسماليّة قد انتصرت، وأنّ الشيوعيّة قد فشلت، وسقطت إلى غير رجعة. والرّأسماليّة هنا، بما هي من خيار حضاري، قيمي، اقتصادي، سياسي، واجتماعي...
ثم لم تمض ثلاثة عقود حتّى انتشرت جائحة كورونا، لتكون بمثابة إيذان إضافي بفشل الرّأسماليّة، وسقوطها الحضاري. وهو ما سوف يدفع العقل البشري إلى مراجعة مساراته الحضاريّة، وإلى محاولة البحث عن خلاصه الحضاري، واجتراح سبيل مختلف عن كلا الطّريقين: الشيوعية والرّأسماليّة. فهل من طريق ثالث يمكن أن يهتدي إليه هذا العقل، يبني عليه تجربة مختلفة، توصل إلى خلاصه، وسعادته، ورفاهه؟
نعم، قد يكون لدى هذه البشريّة التّائهة طريق ثالث، وإن لم تتبلور جميع معالمه، لكنّه قائم وموجود، ويمكن أن يبنى عليه، وتلتقي عنده جميع الأمم، والشعوب، والمذاهب، والدّيانات، والمدارس الفكريّة على اختلافها. وهو يتمثّل في العدالة كخيار حضاري، ومدرسة فكريّة متكاملة، وهو على وجه التّحديد العدالة، كمعطى قيمي ومطلق ومعياري، وكفلسفة أخلاقيّة شاملة.
قد يقول قائلنا إنّ العدالة على مرّ التّاريخ هي أيقونة البشريّة، وعنوان مسارها. وهو صحيح إلى حدٍّ ما؛ لكنّه في مجمل حركته- كمسار- يقتصر على الشعار، وعلى مقاربات سطحيّة، وأكثر من خطاب، لا يهتدي إلى جوهر تلك العدالة وحقيقتها، فضلاً عن المنظومة القادرة على تسييلها.
ببيانٍ آخر، فإن التجارب البشريّة في مجملها، إمّا أنّها لم تنظر إلى العدالة كأولويّة قيميّة، وكميزان نظري فلسفي، بل قدّمت عليها قيم أخرى، كما هو الحال في الليبراليّة، وخصوصاً في مجالها الاقتصادي، التي تقدّمت فيها قيمة الليبراليّة على قيمة العدالة، وهو ما يتبدّى في كثير من المقاربات النّظريّة والفلسفيّة، فضلاً عن الواقع الماثل. وإمّا أنّها اقتربت من جعل العدالة كقيمة أولى، ومطلقة، ومعياريّة، لكنّها افتقدت إلى المنظومة القيميّة، والأخلاقيّة، والمعنويّة، والرّوحيّة... القادرة على إحالة قيمة العدالة إلى واقع تربوي، ثقافي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، قانوني..؛ وبالتّالي عجزت عن الوصول إلى بناء العدالة اجتماعيّاً، وتربويّاً، وفي أكثر من ميدان ومجال.
وقد تكون لدينا نماذج تنطوي على العدالة كقيمة أولى ومعياريّة، وتحتوي على تلك المنظومة القيميّة والأخلاقيّة والتّربويّة، القادرة على بناء العدالة في الاجتماع العام في مختلف ميادينه، لكن أكثر من التباس نظري أو تاريخي أعاق، وما زال يعيق، فعل العدالة هذا، وتسييله، كما هو الحال مع أكثر من فكر ديني أو خطاب، حيث نحتاج إلى إعادة تعريف الأديان، والإلهيّة منها على وجه التّحديد، على أنّها دين عدالة بالدّرجة الأولى، وقبل أيّ شيء. وهو ما يقود إلى إعادة بناء الفكر الدّيني، وخطابه، وثقافته، بطريقة مختلفة، ترتكز فيها على العدالة كأساس مكين، وتتمحور حولها في بنيتها، وفي المحتوى والغايات. وهو ما سوف يترك أثره البالغ على الاجتماع العام في مختلف ميادينه.
ولذلك يمكن القول بشكل عام، إن العدالة تعاني من احتباسين اثنين، احتباس نظري يرتبط برؤية العدالة وفلسفتها وموقعها الفكري، واحتباس عملي يتّصل بالإمكانيات المتعلّقة بتسييل هذه العدالة ووجود المنظومة القيميّة والأخلاقيّة والتّربويّة القادرة على هذا الفعل، وصولاً إلى المبادرة بهذا الاتّجاه في سياسات ومشاريع وبرامج ذات صلة.
إنّ العديد من التّجارب التّاريخيّة التي فشلت في إقامة العدالة، وبسط سلطانها، وتحويلها إلى ثقافة اجتماعيّة شاملة؛ قد يكمن السبب الأساس، الذي أدّى إلى ذلك الفشل، في أنّها لم تهتد إلى المصدر الأساس الذي يمكن أن ينبثق منه فعل العدل، أو يصدر عنه ارتكاب الظّلم؛ وأنّها لم تضع يدها على المنطلق، الذي منه ومن خلال إصلاحه، يمكن الوصول إلى صناعة العدالة وإقامة بنيانها، هذا فضلاً عن العديد من المقاربات النّظريّة والفلسفيّة للعدالة وحقيقتها، والتي لم تتجاوز الإطار الخارجي والمادي إلى المحتوى النّفسي والجواني، واقتصرت في سعيها إلى إقامة العدالة على كيفيّة توزيع الثّروة بشكل عادل، أو اعتماد سياسات ضريبيّة عادلة، أو توزيع الدّخل بطريقة تنسجم وقيم العدالة، هذا في المجال الاقتصادي، وكذلك الأمر في المجال السياسي، فيما يرتبط بمقاربة السّلطة وإدارتها، أو في المجال القانوني، أو في العلاقات الدّوليّة، وسوى ذلك من مجالات. وهي في مجملها قد غفلت عن المحتوى الحقيقي للعدالة، وحقيقة جوهرها، والمعنى الخالص من فلسفتها.
وعلى سبيل المثال، إنّ إيجاد التحول في ملكيّة وسائل الإنتاج من الطّبقة الرّأسماليّة إلى غيرها، كما هو في الماركسيّة، واعتماد مبدأ تدخّل الدّولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بمستوى أو آخر، كما هو لدى بعض المنظّرين في الفضاء الرّأسمالي، وذلك لتحقيق عدالة مرتقبة؛ يبقى هذا كلّه في الإطار المادّي، ولا يلامس الموطن الأساس لاستنبات العدالة، ولا يبلغ المنبع الأشد غوراً لصناعة العدل وتشييده.
ومن هنا يبدأ التّمييز بين عدالة أشدّ أيديولوجيّة، وبين عدالة أشدّ فطريّة، ويبدأ البحث في فلسفة للعدالة ربّما تؤسّس للقدرة على صناعة العدل وبسط القسط، بعد فشل أكثر من تجربة عدالة، وانكشاف أكثر من أيديولوجيا عدالة، بسبب من ظاهريتها وقصورها عن بلوغ أصل العدل ومنبع الظّلم.
أمّا الطّرح البديل فهو أطروحة عدالة ترتكز على فلسفة أخلاقيّة([1])، تحيل العدالة إلى جذر نفسي، وبعدٍ تربويّ، بحيث يعمل على صناعة العدالة في النّفس قبل الفعل، وفي الضّمير قبل الاقتصاد، وفي الوجدان قبل القانون، وفي الثّقافة قبل السّلوك، وفي داخل الإنسان قبل المجال العام.
إنّها فلسفة عدالة جوانية، ترنو بالدّرجة الأولى إلى صناعة إنسان العدالة، وترى في توطين العدالة في النّفس الإنسانيّة أساساً متيناً ومضموناً لفعل العدل، وأنّ إصلاح هذه النّفس بالعدالة هو المنطلق الصّحيح لأي إصلاح في المجال العام، حيث ترى في هذه النّفس منشأ العدل ومنبع الظّلم على حدّ سواء. وما مظاهر العدل أو الظّلم التي نراها في أيّ من مساحات الاقتصاد أو الاجتماع أو القانون وغيره، إلّا بمثابة تجليات وانعكاس لمدى تحقّق كلّ من هاتين المقولتين في داخل النّفس الإنسانيّة.
أمّا إن ذهبنا إلى أيّ تمثل من تمثلات العدالة وتجلّياتها، دون أن نعمد إلى تنظيف النّفس الإنسانيّة من الظّلم القابع فيها، والجور الساكن في جوفها؛ فلا بدّ أن يجد هذا الظّلم طريقاً له إلى الخارج، وأن يلتمس الجور منفذاً له يعبر من خلاله، ليظهر في أيّ من مجالات الاجتماع العام في الاقتصاد أو السياسة أو القانون أو غيره.
إنّ ما ينبغي قوله هو إنّه إن أردنا الوصول إلى العدالة وتجنّب نقيضها، فما علينا إلّا أن نغور في الإنسان نفسه، لأنّ منه الظّلم وإليه يعود العدل، ومن أعماق نفسه يصدر كلا الفعلين.
وهو ما يستدعي منّا أن نميّز بين المنشأ والمتعلق، سواءً كنا نبحث في مقولة العدل أم في مقولة الظّلم، فمنشأ أيّ منهما هو النّفس الإنسانيّة، أما المتعلّق فقد يكون المال أو العقار، السّلطة أو القانون، الاقتصاد أو الاجتماع، أو أيّ من الأفعال أو الأقوال خارجاً على إطلاقها، وسعة حضنيها.
والخطأ الذي وقعت فيه أكثر من نظريّة عدالة، أو أيديولوجيّة ذات صلة، أنّها غرقت في المتعلق، وغفلت عن المنشأ. ولذلك بنت كلّ أطروحتها في الوصول إلى مقصد العدالة على المتعلق خارجاً، ونسيت المنشأ داخلاً، فأخفقت في الوصول إلى عدالة صلبة في تمثّلاتها الخارجيّة، أي إلى عدالة ذات دفع ذاتي ومستديم في شتّى مجالات الاجتماع العام وشؤونه، بحيث لا تعاني من الانحراف أو الخفوت أو الارتكاس في سيرها ومسارها. ومن هذه النقطة بالذات نستطيع أن نعي لماذا كانت مجمل التجارب البشرية تصل إلى الفشل، أو إلى بعضٍ أو كثيرٍ منه في سعيها إلى تحقيق العدل وكبح الظلم.
إنّ في النّفس الإنسانيّة استعداداً للعدل والظّلم، وبمقدار ما يستطيع المرء أن يكون وسطاً بين نفسه والآخر، يمكن له أن يصل إلى عدله وأن يفارق ظلمه. أي المطلوب أن يخرج الإنسان من نفسه، من سطوتها، وسلطانها، وميولها، وشهواتها، وأهوائها حتّى يستطيع أن يجعل لنفسه ميزاناً بينه وبين غيره.
يمكن للإنسان أن يكون عادلاً بمقدار ما يخرج من عبوديّة نفسه، وتعظيم أناه، وتضخيم ذاته، وتعاليه المزيّف، بحيث لا يميّز نفسه عن الآخر، ولا يجنح إلى ميولها، ولا يتحيّز لرغباتها، ولا ينحاز إلى شهواتها، ولا ينغلق على ما يريد، ولا يحبس همّه فيما يصلح له أو ينفعه؛ وهو ما يؤسّس لمقولة الإنصاف مع الآخر - أيّ آخر فرديّاً كان، أم جمعيّاً، أو قوميّاً أو طائفيّاً أو عرقيّاً أو مناطقيّاً... - والتي تعني أن يرى الأمور من زاوية الآخر كما من زاويته، وأن ينظر إلى مصلحة الآخر، كما إلى مصلحته، وأن يهدف إلى نفع الآخر كما إلى نفع نفسه، وأن يكره للآخر ما يكره لنفسه، وأن يحبّ للآخر ما يحبّ لنفسه، وبالمستوى نفسه الذي يكره لنفسه، أو يحبّ لها؛ أي أن تستوي نفسه مع الآخر، ولا تتمايز عنها. نعم إن كان للتمايز من محلّ، فهو تمايز- وتحديداً تفاضل- قيمي، وليس عنصرياً، بمعزل عن شكل هذه العنصرية وتمثّلها.
وهذا يعني أنّ للإنصاف بعدين أساسيّين: بعد معرفيّ، يتّصل باستواء النّظرة للأنا والآخر، وبعد وجداني، يتّصل بالشعور تجاه الآخر - حباً وكرهاً وإرادة خير - بالمستوى نفسه تجاه الذّات والأنا([2]). وهو ما يؤسّس لبعد عملي تتوزّع تمثّلاته وتجلّياته في أكثر من ميدان وصعيد.
وهي في الصميم فلسفة عبوديّة الله تعالى، والتي لا تتمّ إلّا بالخروج من عبوديّة الأنا، والتي لا بدّ أن تقود - إذا ما تحقّقت فعلاً، لا قولاً وطقساً - إلى الانصاف في العلاقة مع الآخر، وإلى العدل في معاملته، وإلى أن تكون النّفس ميزاناً بين الذّات والغير. وهي الوظيفة الأساسيّة للأديان الإلهيّة، أي صناعة إنسان العدالة، تمهيداً لمجتمع العدالة، حيث لا يكون التّخلق بأخلاق الله العادل إلّا بالتزام صيرورة العدالة، ولا يستطاع السير إلى الله العادل إلّا بتمثّل العدل ونهجه([3]).
أي إنّ النتاج – ومن جهة أخرى: الشرط - التلقائي للدخول في عبودية الله تعالى، هو الخروج من عبودية الأنا. وهذا الخروج من عبودية الأنا([4]) يوجد الأساس المكين لفعل العدل وتشييد الإنصاف. وهذا يعني أن المؤدى التلقائي لعبودية الله تعالى، هو إقامة العدل ونفي الظلم. وهذا يعني أيضاً أن أية ممارسات عبادية لا تفضي إلى الخروج من عبودية الأنا، وتالياً إلى القدرة على فعل العدل، وممارسة الإنصاف في العلاقة الآخرين؛ هي ممارسات عقيمة، وفاقدة لروحها، ومبتورة عن مقصدها.
وعلى ما سلف، يمكن لنا أن نعي لماذا يُعتبر الدفاع عن التوحيد دفاعاً عن العدالة، إذ إنه يقوم على فلسفة وصلٍ ما بين توحيد الله تعالى والعدالة، من جهة أن توحيد الله تعالى وإحلاله في الوعي والوجدان، يفضي إلى –أو يقوم على- الخروج من أية عبودية أخرى للأنا والهوى وجميع متعلقاتهما، وهو ما يسمح بإيجاد أساس معنوي وقيمي لتوطين العدل في النفس، وإسكان الإنصاف لديها. أي إن التوحيد يفتح على عالم الألوهية بما يحمله من مخزون قيمي وروحي داعٍ إلى التربية على العدالة والتنشئة عليها، ويُبعد عن العبوديات الأخرى من مادية وأهوائية، وما يمكن أن تؤدي إليه تلك العبوديات من إنحياز إلى الأنا ومتعلقاتها، وهو انحياز يقود إلى إيجاد منشىء للظلم والجور في النفس، لا بدّ أن يعبر منه إلى الخارج فعلاً وسلوكاً. أي إنّ الخروج من جميع تلك العبوديات والصنميات على اختلافها وتنوّعها، والدخول في عبودية الله وحده؛ يهيّء النفس لتلقف معاني القسط والعدل - بل هو نفسه بمثابة ولوج إلى جوهر العدل والتّخلّق به -، ويدفعها إلى التحلّي بالإنصاف، ويفضي إلى حصانتها من الظلم والجور والعصمة منهما.
وبناءً على مجمل ما تقدّم، يمكن لنا نسج ميزان، يتيح لنا أن نتلمّس مدى محاكاة أو مفارقة أي خطاب ديني أو سلوك للهدف الأساس والمقصد الأوّل الذي كانت الأديان من أجله، وجاءت لتحقيق غايته، إذ إنه بمقدار ما يعبّر عن العدل وقيمه، بمقدار ما يحكي طهرانيّته وصفاءه، وبمقدار ما يفارق الإنصاف وميزانه، بمقدار ما يحكي تشوّهاً أصابه، أو انحرافاً ألمّ به.
ومن هنا نستطيع أن نفهم هذا المخزون المعنوي، والرّوحي، والقيمي، والأخلاقي، والتّربوي الهائل الذي جاءت به الأديان الإلهيّة، والذي يهدف الى ترويض النفس، وتهذيبها، وكبح جموحها، وضبط جماحها، وغلبة أهوائها؛ إنّه من أجل هدف أساس، وغاية أسمى، وهي صناعة الإنسان العادل، وتزكية نفسه بالعدل؛ مع كون هذا المخزون - وللأسف الكبير - لم يتحوّل في مجمله إلى ثقافة عامّة لدى العديد من المجتمعات البشريّة على أنواعها، وذلك لغلبة الفلسفات الماديّة، وطغيان ثقافة المادة، وهجران الرّوح، ونسيان النّفس، والإزدلاف إلى صنمَي الدهر: السلطة والمال.
وحتّى لا يلتبس الأمر على قارئنا، فيرى أنّنا جنحنا إلى شيء من المثاليّة أو الطوباوية أو الانفصام عن الواقع، فلا بدّ من بيان التّالي:
- إنّ فشل مجمل التّجارب البشريّة، التي قاربت العدالة مقاربة ظاهريّة أو ماديّة؛ تقدّم مؤشّراً أو دليلاً على ما نقول.
- إنّ فشل العديد من التّجارب الدّينيّة في تحقيق هذا الهدف، لا يعني أنّ الأديان في مضمونها الصافي لا تحمل هذه الغاية، وإنّما الالتباسات التّاريخيّة قد طغت على المحتوى الدّيني، وحرفته عن مساره، وشوّهت معالمه.
- تحدّد لنا هذه المقاربة المنهج الذي يجب أن نسلك للوصول إلى عدالة صلبة، تمتدّ جذورها إلى النّفس الإنسانيّة، وإيمانها، وضميرها، ووجدانها. وتبيّن لنا تالياً كافة الأطر والسياسات، التي يجب أن تعتمد لبلوغ ذلك المقصد. وهو - أي ذلك المنهج - المنهج التّربوي والأخلاقي بالدّرجة الأولى، لأنّ السؤال الأساس الذي يحتاج إلى تقريب الجواب عليه هو هذا السؤال: كيف نستولد عدالة شاملة وصلبة؟ أي كيف نصل إلى عدالة تمتلك دافعاً ذاتيّاً، ينبع من أعماق النّفس الإنسانيّة، وتستوعب جميع مجالات الحياة الفرديّة، وميادين الاجتماع العام؟ وسؤال ال"كيف" هذا وجوابه، هو سؤال المنهج وجوابه، وهو الذي يحدّد جميع السياسات والبرامج والسّبل والأدوات... التي يجب أن تعتمد لتحقيق العدالة المنشودة.
وهذه المقاربة وظيفتها الأساس أن تجيب على هذا السؤال، أي سؤال ال"كيف" في نواته الأولى، وسؤال المنهج في مبتدأ رحلته، وجوابه الذي يبيّن لنا التّوجّه العام، الذي يجب أن يُسلك في هذا السياق، وهو العدالة الأخلاقيّة كمعطى فلسفي، معرفي، ديني... تترتّب عليه، وتُستلّ منه، وتتفاعل معه مضامين اجتماعيّة، واقتصاديّة، وسياسيّة، وغيرها، يتمّ تخصيبها في إطار هذه الفلسفة، وفي خضمّ هذه الرّؤية.
لعلّ أهميّة هذه المقاربة تكمن في أنّ صحراء التيه وزمن الضياع يبدآن من هذه النّقطة بالذات، وأن اختلاف التّجارب البشريّة السّاعية إلى تحقيق عدالة ما يبدأ من ذاك السؤال وجوابه، الذي عند مفترقه تتشعّب مسارات البشرية، وتختلف طرقها.
إنّ المقاربات التي تحبس العدالة في إطار مادّي اقتصادي يتمحور حول توزيع الثّروة، لن يتعدّى مشروعها لتحقيق عدالة اقتصاديّة - اجتماعيّة هذا الإطار، حيث ستكون بدايته من توزيع الثروة، ونهايته في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يترتّب عليه سياسات وبرامج وأدوات تنسجم معه.
ومن يرى أنّ العدالة السياسيّة تنبع من توزيع السّلطة وعدم حصرها، فإنّ مشروعه للعدالة سوف ينحصر في عمليّة الفصل بين السلطات، وما يستتبعه ذلك من نتائج ومترتّبات في أكثر من مجال، وعلى أكثر من صعيد. وكذلك الأمر في موارد أخرى.
وفي هذا الحال - أي عندما تحبس العدالة في إطار مادي اقتصادي أو سياسي... فإن أقصى ما يمكن الوصول إليه هو نمط اقتصادي أو سياسي.. قد يحاكي شيئاً من العدالة، لكنّه لا يشمل جميع أبعادها، وقد ينقلب في أي حالٍ أو آنٍ إلى ضدّه وخلاف مقصده، لأنّه لا يقوم على أرض صلبة، ولم يهتد إلى المنبع الأساس لمقولتي العدل والظّلم، ولم يعالج الجذر الأساس المولّد لهما، وهو قابل للالتفاف عليه، وسوقه إلى خلاف هدفه.
أمّا المقاربة التي ترى في العدالة جذراً في النّفس، ونبتاً في الوعي والوجدان؛ فسوف يكون مشروعها للعدالة مختلفاً، حيث يبدأ من النّفس ولا ينتهي عندها، ويشرع من التّربية ومن ثمّ يتجاوزها. أي إنّ ذاك المشروع سوف يكون مشروعاً تربويّاً - أخلاقيّاً في منطلقه، يقوم على أسس فلسفيّة وفكريّة ومعرفيّة، ليتكامل ويشمل مجمل الأبعاد الأخرى ذات الصّلة من قانونيّة واقتصاديّة واجتماعيّة وغيرها في مراحله اللّاحقة.
إنّ حسم الموقف من الجوهر الفلسفي للعدالة ونواتها الأولى، هو الذي يحدّد لنا أي مشروع ننتهج، والسياسات والبرامج والأدوات وجميع الخطوات ذات الصّلة، ويؤسّس لاتّجاهات أكثر واقعيّة، وأوسع شموليّة، وأشدّ قدرة على إنتاج العدل، ويوفّر أرضيّة صلبة تتيح تشييد مسارات أبعد استدامة، وأقرب إلى بلوغ الغاية.
- إنّ ما نتحدّث فيه عن تأسيس معنوي، قيمي، أخلاقي، تربوي للعدالة؛ إنّما هو مجرّد بناء تحتي ومنطلق لما بعده، أي إنّ أيّة بناءات فوقيّة اقتصاديّة أو اجتماعيّة أو سياسيّة... تفتقد إلى هذا التّأسيس القيمي للعدالة، هي بناءات لا تقوم على أرض صلبة، ويمكن أن تسقط أو تتهاوى لدى أي اهتزاز، أو اختبار، أو عوامل ذات أثر.
وفي المقابل، فإنّ أيّ بناء تحتي – قيمي، أخلاقي -... لا يتكامل ويكتمل مع بناءات فوقيّة في مختلف مجالات الاجتماع العام، هو بناء ناقص، وغير مكتمل، وفاقد لوظائفه في مختلف المجالات الاجتماعيّة ذات الصّلة.
إنّ هذه الفلسفة الأخلاقيّة للعدالة والإنصاف هي مجرّد تأسيس وبناء تحتي لما فوقها، وهي لم تُطرح لتكون بديلاً عن جميع البناءات الفوقيّة المعرفيّة من اجتماعيّة، واقتصاديّة، وسياسيّة، وغيرها، وإنّما لتكون منطلقاً لها، وأساساً لبنيانها.
- إنّ الشأن الأخلاقي هو شأن معرفي وواقعي بامتياز، ولا يصحّ الفصل بين المضمون الأخلاقي لأيّة صيرورة اجتماعيّة، وبين جميع تشكّلاتها المعرفيّة من اقتصاديّة أو سياسيّة أو اجتماعيّة وغيرها، والوقائع التي تنبني من خلالها، ومجمل مؤدياتها ونتاجها.
إنّ الشأن الأخلاقي هو شأن اجتماعي، واقتصادي، وقانوني، وثقافي، وسياسي وغيره. ويخطئ من يعتمد الفصل بين الأخلاق، وبين واقع الاجتماع العام، وطبيعة تشكّله، وجميع ظواهره، ومجمل أنماطه، سواءً في البعد المعرفي والثّقافي، أم في الوقائع الملموسة والماثلة.
إنّ الانزياحات العديدة التي شهدتها التّجربة الرّأسماليّة إلى اللّاعدالة، لا تبتعد عن الجذر الأخلاقي في مضمونه الفلسفي والمعرفي، لأنّه لا يمكن النّظر إلى أطروحة مركّزة الثروة، ومنفعة الأغنياء، وترف القلّة، بعيداً عن غواية المال، وشهوة الجمع والتّكاثر، حيث تتجاوز البناءات الفوقيّة المعرفيّة في الاقتصاد وغيره أن تكون مجرّد تبرير لذاك المحتوى الأخلاقي على صلاحه أو فساده، وإنّما البعد المعرفي يتخلّق مع ذاك المحتوى الأخلاقي في علاقة شبه جدليّة، تنتج تلك البناءات الفوقيّة في الاقتصاد أو الاجتماع وغير ذلك. أي إنّ من حصل لديه ذلك الانحياز إلى أناه - ولو بالمعنى الفئوي أو الاقتصادي..-، والميل الى هواه، وافتقد الانصاف في داخله؛ لن يقارب موضوع الاقتصاد وقضاياه مقاربة إنصاف وعدالة. وفي المقابل، إن من استوطن الإنصاف في نفسه، لن ينظر إلى الاقتصاد في بنيته إلّا نظرة إنصاف، فهو لن ينحاز إلى القلّة المترفة أو الكثرة العاملة، وإنّما يسود لديه نوع من التّوازن في النّظرة إلى كليهما قيميّاً وأخلاقيّاً ونفسيّاً... بما يستولد بناءات فوقيّة معرفيّة في الاقتصاد، تعكس ذلك التّوازن، وتستبطن ذلك الإنصاف، وترعى مصلحة المجموع، ومنفعة المجال العام، دون عصبويّة، أو بغي، أو حقدٍ على طبقة، أو جنوحٍ إلى ظلم.
إنّ ما تقدّم يرتكز على فلسفة مفادها أن الإنسان لن يكون إلّا كما هو. أي لن يكون في الخارج إلّا كما هو في الدّاخل. فعلُه يحكي عنه، ونتاجه ثمرة جوفه، ووعيه حصيلة ضميره، ولسانه ترجمان قلبه، وما استقرّ في النّفس يتبدّى في الفكر والثّقافة والسّلوك. هي معادلة جدليّة بين الدّاخل والخارج، كلّ منهما يعطي الآخر، ويأخذ منه. وإن كان ما تقدّم يضيء على إحدى جنبتي هذه المعادلة، وهو ما يتّصل بتأثّر البناء الفوقي المعرفي من اقتصادي واجتماعي وقانوني... بحقيقة النّفس، وجوّانيتها، وتولّده منها.
ورسم هذه المعادلة الجدليّة ليقال - في موضوع البحث - إنّه بمقدار ما يُعمل على إحلال الإنصاف في النّفس (من خلال فعل التخلّق، وسلوك التطهّر، والإيمان بمنظومة العدل هذه)، بمقدار ما سوف يتبدّى هذا الإنصاف في الفعل والرّأي. وفي المقابل، بمقدار ما يُجترح عدلاً في السّلوك، وإنصافاً في الجوارح، بمقدار ما يؤول فعله هذا عدلاً وإنصافاً في الجوانح وحقيقة النّفس، لتشبه النّفس فعلَها، وتستقي من جوارحها، وتلبس من لباس البدن، وإن كانت هي أيضاً تغدق عليه من لباسها.
إنّ هذا التّحليل لا يلغي المعرفي، ولا يُضمر دوره. وإنّما يسعى إلى البحث في مناشئه، وفي أسباب تخصيبه، وفي نطفته الأولى، ليكون النّظر إليها، وبدء الإصلاح منها، وليُستقلع الظّلم من أُسِّه، ويعود العدل إلى مهجره.
إنّ تحليلنا لافتقاد العديد من الدّول والمجتمعات لمنظومة اقتصاديّة واجتماعيّة عادلة، إنّما يحيلنا بالدّرجة الأولى إلى سببٍ أخلاقي. وإن انكشاف العديد من الدّول عن نظام صحي يفتقد إلى العدالة بين الأغنياء والفقراء، إنّما يحيلنا أيضاً، وبالدّرجة الأولى، إلى سببٍ أخلاقي.
وأعود للتّأكيد، أنّنا هنا لا نتحدّث عن الأخلاق بالمعنى السلوكي الظاهري فقط، وإنّما نتحدّث عن فلسفة أخلاقيّة ذات مضامين وأبعاد معنويّة معرفيّة ثقافيّة تربويّة اجتماعيّة... قادرة على صناعة إنسان العدالة، ومجتمع العدالة، بالارتكاز إلى مجمل تلك المنظومة القيميّة والأخلاقيّة التي جاء بها الدّين.
وما لا بدّ من التّأكيد عليه، هو إن الأديان الإلهيّة في جوهرها المنفصم عن الصّيرورة التّاريخيّة تمتلك تلك المنظومة وذاك المحتوى. أي إنّنا نحتاج إلى الفصل بين الدّين في معانيه الصافية، وبين الدّين في العديد من تجاربه التّاريخيّة، وتحديداً تلك التي أخذت مساراً سلطانيّاً، أو خضعت لسطوة الظّروف التّاريخيّة، وتلوّثت بوقائعها، وتشوّهت بالكثير من التباساتها.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإنّنا نجد في تراث مدرسة أهل بيت النبي(ص)، وما يحويه من مخزون قيمي وأخلاقي رائع نموذجاً لما نتحدّث عنه، من توفّر الأديان في صورتها النّقيّة على ذلك المضمون، وتلك المنظومة ذات الأبعاد المعنويّة والأخلاقيّة والاجتماعيّة والقيميّة الهادفة، وذلك لما ينطوي عليه ذلك التّراث من بعد معنوي زاخر، ومن محتوى قيمي واسع، ومن غنى في المضمون الأخلاقي والتّربوي، بما يسعف القاصد إصلاح نفسه بالعدل، وإشباع وجدانه بالإنصاف.
وقد يقول قائل، إنّ ما تقدّم ينطوي على دعوة إلى عودة الدين إلى الاجتماع العام([5])، مع أن من يقرأ التجارب (الدينية) في التاريخ القريب والبعيد، يصل إلى نتيجة مفادها، أن مجمل تلك التجارب قد أفضى إلى نتائج غير مشجعة في أكثر من مجال، وأكثر من حقبة تاريخية.
في مقام الجواب، لا بدّ من القول إنّ ما تقدم من مقاربة لا ينطوي البتة على استعادة مجمل تلك التجارب التي توصف بكونها دينية، وهي في جوهرها مجافية للدّين وحقيقته، وكانت من أهم الأسباب لتشويه الدّين والنفور منه، بل هي مقاربة تسعى إلى بيان المنهج، والمضمون، الذي قد يفضي إلى تدشين طريق ثالث، وفتح كوة في جدار الانسداد الحضاري، الذي تعاني منه البشرية، وهي محاولة للإضاءة على سبيل الخلاص الحضاري، الذي تسعى إليه البشرية، وتجهد للحصول على بارقة توصل إليه.
إنّ هذه المقاربة تريد القول إنّ العدالة بذاك المعنى وتلك الفلسفة؛ هي سبيل الخلاص، وترياق التّيه([6]). وإذا ما بحثنا في مجمل الموجود المعرفي الإنساني، فإننا نجد أن المضمون الديني في صورته النقية والصافية، تتوفّر لديه مجمل تلك القيم، التي تسهم في صناعة إنسان العدالة، وتتوفّر لديه أرضية أخلاقية خصبة للتربية على العدالة، وتدشين مساراتها.
و هنا، لا بدّ من الإلفات إلى ما يلي:
أولا: إن هذا المضمون قد نجده أو بعضاً منه لدى العديد من الأديان - في صورتها النقية، ونسختها الصافية - كما لدى بعض الفلسفات أو المدارس الفكرية، أو حتى التجارب الإنسانية التي حاكت الفطرة البشرية، أو استلهمت من بعض القيم الاجتماعية البشرية ذات المنشأ الديني.
ثانيا: لا يعني ما تقدّم أن نأخذ من الخطاب الديني جميع ما فيه، وكلّ ما لديه، وإنما نأخذ منه ما يسهم في الوصول إلى تلك الغاية، ويسعف في بلوغ ذلك المقصد. أما ما يؤدي إلى خلاف ذلك، فينبغي أن يُعمل على كنسه، وتطهير المضمون الديني منه.
ثالثا: إنّ ما تقدم من مقاربة، في الوقت الذي يفتح فيه على الأخذ من المضمون الديني - كما من غيره -، فإنه "يقدم أيضا" معياراً وميزاناً، يمكن من خلاله تقييم تلك المعطيات الدينية ذات الصلة بالبعد القيمي والمفهومي، بحيث يميّز بين ما كان منها مؤدياً إلى ذلك الهدف وتلك الغاية، فيُعلم أنه من الدّين ومن صلبه، وما كان منها مبعداً عن ذلك الهدف، وتلك الغاية، فيُعلم أنه ليس من الدّين، وينافي حقيقته.
فمثلاً - وحتى لا يشتبه الأمر على البعض، فيظن أننا نخضِع الدّين في جميع معطياته لتقييم الذوق البشري، وهو ليس كذلك -، هناك من يخلط بين الطائفية في مضمونها العنصري، وبين الدّين في محتواه القيمي، فيعمل على رمي جميع مثالب الطائفية على الدّين وأهله. وفي هذا خلطٌ، وظلم، وكثير من الافتراء. مع أنه إذا ما تأملنا في حقيقة الطائفية، نجد أنها نوع تعظيم لأنا الجماعة، المتمثّلة هنا في الطائفة، وإعلاء لهذه الأنا على أنا الجماعة (الطائفة) الأخرى، لمجرد أن هذه الأنا هي أنا ال(نحن)، وتلك الأنا هي أنا ال(هم)، أي إنّ هذا الإعلاء هو إعلاءٌ عنصري، وليس إعلاءً قيمياً مبنياً على التفاضل القيمي.
وهو يتضمن نوع عبودية لهذه الأنا الجماعية، والذي يعبّر عن نفسه من خلال تعظيمها، والإعلاء من شأنها، وتفضيلها بما هي أنا ال(نحن) على أنا ال(هم).
وبالتالي هي تتنافى وجوهر العدالة ومقصدها الهادف إلى إخراج الأنا - فردية أو جماعية - من عبودية الذات إلى عبودية الله، ومن التعالي إلى التواضع، ومن التفاضل العنصري إلى التفاضل القيمي، ومن العنصرية إلى الإنسانية، ومن التشرنق الأنوي إلى التناصف في الرؤية والوجدان.
وبناءً على هذا المعيار يتبيّن أن مقولة الطائفية ليست من الدّين في شيء، بل هي تتنافى معه([7]). ولذا ينبغي العمل على إخراجها من الخطاب والثقافة، وإفقادها أية مشروعية دينية مدّعاة يمكن أن تتلطّى بها، أو تتستّر بلباسها.
وهذه المقاربة التي تنطبق على الطائفية تنطبق أيضاً على جميع المقولات العنصرية الأخرى، بمعزل عن تمظهرها، والتعبير الذي تأخذه، سواءٌ كان قومياً أم مذهبياً أم إثنياً أم جهتياً أم مناطقياً أو حزبياً، بل وحتى أيديولوجياً وغيره؛ لأنها جميعها في المضمون واحد، وفي المحتوى تتشابه. إذ إنها تنطوي على تعظيم تلك الأنا في مقابل الآخر، وتكبّرها عليه. وهو يعني أن سبب الانحدار إلى الظلم في جميعها واحد، وأن العلاج لديها متجانس.
وكذلك الأمر عندما تُعرض بقية المفاهيم والمعطيات القيمية على معيار العدالة وميزان الإنصاف، فإنه يمكن لنا أن نتبيّن ما الذي يتماهى والدين منها، أو يتنافى معه.
وعليه، ليست دعوة إلى استجرار تلك التجارب الفاشلة، التي تنسب إلى الدين، وليست منه، وتحاول أن تتلطى به، وهي لا تشبهه؛ وإنما هي دعوة إلى تدشين مسارات جديدة، تستفيد من أي معطى، يسهم في تعزيز مقولة العدالة القائمة على تلك الفلسفة. مسارات لا تقطع مع أي معطى ديني لمجرد أنه من الدّين، ولا تركن إلى أي معطى قد ينسب إلى الدين، وهو يجافي جوهره وحقيقته ومقصده.
إنّ مجمل التجارب البشرية قد اعتمدت مسارين اثنين، الأول وهو المسار الذي عمل على الالتحاف بالدّين وارتداء لباسه، وإن كان في جوهره وقيمه منافياً له، ومخالفاً لحقيقته. والمسار الثاني هو الذي قطع مع الدّين قلباً وقالباً. وركن إلى وضعيته، واعتمد أشكالاً مختلفة من العلمانية، وإن كانت في مجملها قد نحت إلى البعد المادي، وأغفلت البعد المعنوي والروحي، وهجرت مجمل تلك القيم الأخلاقية والمعنوية التي توصل إلى العدالة، وتنشئ على الإنصاف.
أما هنا، فإنّ المطروح:
1. تدشين مسارات مختلفة تستقي من جوهر الدين القائم على العدالة، وتسعى إلى مقصده الهادف إلى القسط والإنصاف.
2. الانفتاح على مجمل الموجود الديني وغير الديني (الفطري)، الذي يسعف الوصول إلى ذاك الهدف، ويعين على ذاك المسعى.
3. تقديم معيار يمكن من خلاله وعلى أساسه تمييز أي معطى قيمي، يمكن أن يؤدي إلى ذاك المقصد، كما يمكن أن يؤدي إلى خلافه، سواءٌ كان دينياً أم غير ديني، فإن هذا المعيار يصلح لغربلة كل منهم، وذلك من حيث النتيجة التي يمكن أن تترتّب على ذاك المعطى، خروجاً من سلطان الأنا وعبوديتها وسطوتها، أم مزيد تعظيم لها، وإعلاء من شأنها، وتكبّر على أقرانها.
4. إن هذه المسارات تنبع من صميم الفطرة الإنسانية، وتستجيب لعطشها، وتروي توقها إلى حياة تقوم على العدالة الشاملة، التي تستوعب كل شيء وفعل.
5. إنّ محور هذه الأطروحة هو العدالة، وليس التراث على إطلاقه، أو أي شيء آخر. نعم، عندما نجد أن أي معطى ديني – أو فطري - يخدم مقولة العدالة، فينبغي الأخذ به، ولا يصح أن تكون هناك أية حزازة تمنع من الاستفادة منه.
إن فهم الدين في مجمل منظومته على أساس من تلك القيم المحورية والجذرية (العدالة)؛ يتيح لنا أمرين اثنين متكاملين: الأول، فهم تلك المعطيات الدينية بشكل أعمق. والثاني، توظيفها بشكل أفضل، بحيث يعلم المقصد منها، والهدف الذي تسعى إليه. وبالتالي يمكن إدارتها بطريقة توصل إلى ذاك المقصد، وتحقق الغايات المرجوّة منها في التخليق بالعدل، وصناعة وجدانه، وتخصيب ضميره، وتنمية جميع أخلاقياته وسلوكياته.
ومن هنا نستطيع أن نعي تلك العلاقة ما بين الحرية والعدالة، حيث إن التحرّر من سلطان الأنا وأهوائها يفضي إلى تحقّق العدالة في النفس. وفي المقابل، إن الإيمان بمنظومة العدالة في هدفها السامي، ومختلف تعاليمها، ومجمل مفرداتها؛ سوف يفضي إلى ممارسة التحرّر، والاعتقاد به، والالتزام بنهجه وسبله.
هنا يصبح كلٌ من التحرر والعدالة وجهان لمضمون متقارب، حيث لا عدالة من دون حرية، ولا حرية من دون عدالة. الحرية شرط العدالة وطريقها، والعدالة نتاج الحرية، وفي الوقت نفسه مرتكز لها، من حيث أنّ الإيمان بالعدالة كمعتقد سير وسلوك، وكسبيل إلى الله تعالى؛ هو بمثابة مولّد لفعل الحريّة ونهج التّحرّر.
لكن مع الإلفات إلى أن كلاً من العدالة والحرية هنا إنما هو في إطاره الجواني، وبعده النفسي. فنحن هنا نتحدث في معنيين موطنهما النفس، ولا ينحصران به. ينشآن منه، ويتمددان إلى خارجه.
أما عن دور العقل فيما يرتبط بموضوع العدالة هذا، فيمكن القول:
أولاً: إن منظومة العدالة بأجمعها تقوم على أساس من فعل العقل.
ثانياً: إن مقاربة أيّ من المفردات التربوية والسلوكية المؤدية إلى تحقيق العدالة، إنما تتمّ من خلال العقل ودوره، بما هو أداة وعي وفهم.
ثالثاً: إذا كان هوى النفس هو الحاجز دون تحقّق العدالة، وإذا كان كلٌ من الهوى والعقل مقولتان متنافيتان؛ فهذا يعني أنه بمقدار ما ينتعش الهوى ينحسر العقل. وفي المقابل، بمقدار ما يأخذ العقل دوره ويتسع مداه ينقبض الهوى، وتالياً تتمّ صناعة العدالة.
للعقل دورٌ أساس في صناعة العدالة. بل من دون العقل ودوره لا تحقّق للعدالة. وقيمة هذه العدالة أنها تتحقّق بالاختيار، حيث يُمارس هذا الاختيار من خلال منحى صراعي بين الهوى والعقل، فإذا ما كانت الغلبة للعقل فهو ما يؤدي إلى صناعة العدالة، وإذا ما كانت الغلبة للهوى فهو ما يفضي إلى نقيضها، أي إلى اللاعدالة. فالعقل نقيض الهوى، ومن خلال فعل التّعقّل يُستدفع الهوى، فيُستولد العدل.
العقل هو أب العدل، والعدل وليده. بل يمكن قياس مستوى العقل والعقلانية لدى الفرد والمجتمع من خلال قياس مدى العدالة لدى أيّ منهما (الفرد، والمجتمع)، والعكس صحيح. أي إنه يمكن قياس مدى العدالة فردياً ومجتمعياً، من خلال قياس دور العقل ومداه، ومستوى الاشباع العقلاني لدى أيّ منهما. فلا عقلانية من دون عدالة، وإلا كانت عقلانية مزيّفة، ولا عدالة من دون عقلانية، وإلا كانت عدالة خاوية وصوَرية. فهما مقولتان متلازمتان في الخارج والواقع، وإن اختلفتا في المفهوم والوعي.
وفيما يتصل بذلك النقاش الذي يدور حول أن هذه الفلسفة أو تلك للعدالة هل هي فردية، أم اجتماعية؟ تعنى بالفرد، أم تتسع للاجتماع العام؟ فلا بدّ من القول إنّ بعض فلسفات العدالة جنحت إلى البعد الفردي أكثر، في حين إن فلسفات عدالة أخرى عنت بالاجتماع العام، سواءٌ في مجاله السياسي أم الاجتماعي، فكان همّها الوصول إلى عدالة سياسية أو اجتماعية، من دون أن تعنى بالعدالة الفردية، وصناعة إنسان العدالة تربوياً وأخلاقياً، وذلك تبعاً للمباني الفكرية والمعرفية لكلٍ منهما.
أما في هذه المقاربة لفلسفة العدالة، فإننا نبحث في عدالة تجمع البعدين معاّ، الفردي والاجتماعي، الجواني والخارجي. إذ إنها تهدف إلى العدل في الاجتماع العام في مختلف مجالاته السياسية والاجتماعية وغيرها، لكنها ترى أن هذا العدل لا يمكن أن يقف على أرضٍ صلبة، ويكون أدعى إلى بلوغ مقاصده وتحقيق غاياته، وأشدّ استدامة وإنتاجية وضمانة من الانقلاب إلى ضدّه؛ ما لم يكن هناك دوافع ذاتية للعدالة، تنبع من صميم النفس الإنسانية، وتنسجم مع فطرتها، وتتلاءم مع وجدانها، وتجمع ما بين المنافع الذاتية والعامة لإقامة القسط وصناعة العدل، بما في ذلك المنافع المعنوية والأخروية منها.
بل إن هذه المقاربة تذهب إلى أن مجمل ارتكاسات وانتكاسات العدالة، التي احتبست في الشأن العام، وانحصرت في حدوده؛ تعود إلى أنها جافت البعد الجواني، وأغفلت ضرورته، ولم تلتفت إلى أن العدالة في السلوك تنشأ من العدالة في النفس، وأن العدل العام يتشكّل من العدل الخاص، وأن العدل في الاجتماع العام هو -في مجمله- حصيلة العدل لدى مجموع الأفراد، وأن نبتة العدالة تبدأ من تحت التراب، وما فروعها إلا ثمرة بذرها المتخفّي في جوف الأرض.
ومن هنا كانت الحاجة إلى عدالة لا تهمل منبتها، ولا تغفل عن مقصدها. أي عدالة قادرة على الولوج إلى باطن النفس والتموضع فيها، ومتطلّعة في الآن نفسه إلى جميع ميادين الاجتماع العام وحقوله، من سياسية واقتصادية وغيرها، والبناء فيه، والتمدّد إليه.
إن الحديث عن عدالة اقتصادية لا يتمّ –بناء على هذه المقاربة- بمعزل عن أخلاق عدالة اقتصادية، كما إن الحديث عن عدالة سياسية لا يتمّ بمعزل عن أخلاق عدالة سياسية. وهكذا الأمر في بقية المجالات المعرفية والاجتماعية والعلوم ذات الصلة([8]).
إذن، يمكن القول إن ميزة هذه المقاربة أنها تجمع البعدين معاً. بل ترى أن كلاً من البعد الجواني والخارجي للعدالة هو في جوهره أمرٌ واحد، وإن اختلفت تجلياته وتعابيره، وجهة النظر إليه. بل ترى نوع تكاملٍ بينهما، وأن علاقة جدلية تقوم بين هذين البعدين، بحيث أن كلاً منهما يغذّي الآخر ويستفيد منه، يأخذ منه ويعطيه.
وفي هذا نوع تأسيس لفلسفة شاملة في العدالة، تستوعب جميع الأبعاد، ولا تستثني أياً من المجالات، وتسري إلى أية قضية مهما كان مضمونها، سياسياً أو إجتماعياً أو قانونياً أو إقتصادياً أو في السياسات الضريبية أو في توزيع الدخل والثروات الوطنية...
أما في الرأي القائل إن المقاربة الاسلامية تاريخياً شدّدت على العدالة وأهملت الحرية، وأنه إن كانت الحرية أيقونة الغرب في الفكر والثقافة والسلوك... فإن العدالة هي أيقونة الشرق في مجمل ما تقدّم، وخصوصاً في السياق الإسلامي تاريخياً وحاضراً؛ فلا بدّ من بيان التالي:
أولاً: إن مقاربة العدالة في مجمل التاريخ والتراث الإسلاميين قد تمحورت إلى مستوى وآخر حول العدل الإلهي، والبعد الفردي لها، ولم تعن بالمستوى نفسه بالعدالة في الاجتماع العام. أي هي لم تنظر إلى تلك العدالة الفردية والجوانية (تربوياً وأخلاقيا) ضمن منظومة شاملة، ورؤية أوسع، ترى في العدالة الفردية أساساً للجمعية، وفي الجوانية منطلقاً للعدالة في الاجتماع العام. أي إن الغالب على تلك المقاربة هو بعدها الكلامي، أو الخلقي- الفردي والفقهي، ولم يكن لديها ذلك القصد والتطلّع إلى صناعة مجتمع العدالة ومؤسسات العدالة ودولة العدالة.
ثانياً: بناءً على فلسفة الوصل تلك التي سلفت ما بين العدالة والحرية، يمكن القول إن أية مقاربة للعدالة تنطوي بالمستوى نفسه على مقاربة للحرية. وهو ما يعني أن القول بوجود تلك العناية بالعدالة في السياق الإسلامي، ينطوي ضمناً على القول بوجود تلك العناية وبالقدر نفسه بالحرية. نعم بناءً على الفلسفة الخاصة بالحرية في الإطار الإسلامي، والمحتوى الإصطلاحي النابع منها. وهو ما يفضي إلى القول إن الحرية قد أخذت مداها في السياق الإسلامي، لكن في تعريفها الخاص بها، ومضمونها المستخلص من المباني الفكرية والمعرفية التي يرتكز عليها.
ثالثاً: أما الحديث عن الحرية بناءً على اصطلاحها الغربي، فهو يحتاج إلى مقاربة مختلفة، تتطلّب تعقّب هذا المضمون في التراث والتاريخ الإسلاميين، بمعزل عن المفردات الموازية التي تحمل المضمون نفسه. وهو ما يحتاج إلى بحثٍ مستأنف.
لكن ما لا بدّ من الإلفات إليه، هو إنه فرقٌ منهجي بين مقاربة الحرية في مضمونها الغربي من خلال التاريخ الإسلامي، وخصوصاً في مساره السلطاني، وبين مقاربة الحرية في ذاك المضمون من خلال التراث الإسلامي، لأنه ليس من الضروري أن يعبّر ذاك التاريخ عن ذاك التراث في جانبٍ أو آخر ويحكيه، كما ليس من الضروري أن يكون ذاك التراث قد تموضع في جميع أبعاده ثقافياً واجتماعياً في ذاك التاريخ، أو عُمل على تسييله فيه.
أما إن كانت المقاربة في الإطار التاريخي حصراً، فلا بدّ من تحقيب هذا الإطار وتحديده إجتماعيا وتاريخيا (زمنياً). لأنه لا يصحّ الحديث عن نموذج واحد في الإطار التاريخي الإسلامي، وإنما تتعدّد وتختلف النماذج باختلاف العوامل والأسباب الاجتماعية والثقافية والتاريخية وغيرها، والتي تفضي إلى إنتاج نماذج مختلفة فيما يرتبط بموضوع الحرية في مضمونها الغربي. وهو ما يتطلّب منا مقاربة أكثر دقّة.
وهنا من المفيد الإطلالة على هذه الفلسفة الأخلاقية للعدالة من جهة قدرتها على بناء المجتمعات وهوياتها الجمعية، حيث ينبغي الإلفات إلى أن هذه الفلسفة تؤسس لانتفاء العنصرية في جميع أشكالها وألوانها. إذ إن العنصرية تعني تضخيم الذات والإعلاء من شأنها بالمقارنة مع الآخر، بمعزل عن الشكل الذي تأخذه هذه العنصرية وتعبيرها، في حين أن فلسفة العدالة تلك تفضي إلى استواء النظرة بين الأنا والآخر معرفياً ووجدانياً، وإن كان من باب للتفاضل فهو تفاضلٌ قيمي لاعنصري، وهو ما يؤسس لوجود كلمةٍ سواء قيمية، ولإمكانية بناء مساحة قيمية مشتركة بين مختلف الفئات والجماعات على اختلافها، لأنّ المحتوى العنصري هو محتوى مقفل، في حين أن المحتوى القيمي هو محتوى مفتوح. المحتوى العنصري يمتنع عن أن يلجه من لا يحمل تلك الصفات العنصرية، والتي هي صفات غير إختيارية، في حين أن المحتوى القيمي يقبل أن يلجه كل من يختار الانتماء إلى مضمونه ومعانيه، وهو انتماء إختياري، يمارسه الفرد بفعل العقل والوعي. وهو ما يتيح بناء هويّات قيمية مشتركة تصلح أن تكون أساساً مجتمعياً لتكوين هوية المجتمعات وانتمائها، حيث يمكن لهذه الهوية القيمية أن تكون عابرة لجميع الحواجز العنصرية وقادرة على اختراقها، وتأسيس المشتركات من دونها([9]).
أمّا المضمون القيمي هنا، مع ينبثق منه، ويقوم عليه، فهو العدالة في أبعادها المعنوية والأخلاقية والتربوية والثقافية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية... وما يمكن أن يضمّه أو يؤسّسه هذا المضمون في أبعاده تلك من نموذج مجتمعي، فكري، ثقافي، أيديولوجي وجداني...يصلح أن يبني هوية قيمية جامعة للمجتمعات، ويوفّر قاعدة انتماء صلب لها. وإن كان هذا الأمر مشروطاً بتنمية ذلك المضمون، وتوليده لمنظومة شاملة ومتكاملة ذات صلة.
إن قدرة فلسفة العدالة على التأسيس الهويتي، كما تسري في حال المجتمعات، فإنها تسري أيضاً في حال الدولة([10])، حيث يمكن البناء على تلك الفلسفة للوصول إلى هوية جامعة للدولة، بما يمكن أن يوجد جسور هويتيّة بين مكوّناتها، ويقلّص الشروخ القائمة في الهويات المتعددة لدى هذه الدولة أو تلك، التي قد ينعدم لدى أيّ منها أن تجد عوامل مسانخة لصناعة الهويّة لدى جميع مكوّناتها. أي لا تجد دولة تشترك جميع مكوّناتها في كل العوامل المشكٍّلة لهويتها، وإنما لا بدّ أن تجد أختلافاً ما في أيّ من تلك العوامل، عرقياً كان أو إثنياً أو طائفياً أو مذهبياً أو غير ذلك.
وإن قدرة فلسفة العدالة على التوسّع والتوليد الهويتي من جهة، وقدرتها على تجاوز جميع الحدود والحواجز العنصرية من جهة ثانية؛ يتيحان بناء أساس هويتي صلب وشامل، يصلح أن يشكّل ركيزة قيمية وهويتية للدول، وهو ما يمكن أن يساهم في حلّ العديد من الأزمات التي تواجه تلك الدول من حيث تعمّق الانقسامات والشروخ المجتمعية الموجودة لديها.
بالإضافة إلى ما يمكن أن توفّره فلسفة العدالة تلك من تأسيس صحيح وبنّاء للعلاقة بين الدول نفسها، وإقامة علاقات سليمة، وإعطاء معنى لمجمل تلك المبادىء التي ترتكز عليها العلاقات الدولية، وهذا الأمر يحتاج إلى عملية وصل ما بين تلك الفلسفة وهذه المبادىء. وإن كانت مجمل العلاقات الدولية في بعدها الواقعي تقوم على اعتبارات ومعايير مختلفة عن تلك المبادىء ولوازمها.
بل يمكن الذهاب أبعد من ذلك، وهو إعادة بناء نموذج العولمة، والقائم حالياً على الاعتبارات المادية، ومعايير النفوذ والمصلحة الاقتصادية، وتحويله إلى العدالة في قيمها ومؤدياتها المختلفة، بما يفضي إلى نموذج عولمي يقوم على أساس من العدالة في جميع أبعادها. وهو ما يحتاج إلى أكثر من فلسفة وأيديولوجية وجهة تعمل على رفع العدالة إلى هذا المستوى، وأخذها إلى مديات تصل بها إلى تلك النتيجة.
وبعد أن تطرقنا إلى جملة من القضايا، وعملنا على مقاربتها على أساس من فلسفة العدالة تلك؛ قد يطرح البعض هذه المسألة، وهي أن هذه الفلسفة قد تفتقر إلى معيارٍ موضوعي، يمكن على أساسه ومن خلاله أن يُعمل على قياس مجمل القضايا، لمعرفة مكمن العدل أو الظلم فيها.
والجواب أن هذه الفلسفة تنطوي على قدرة خلّاقة لانتاج معايير موضوعية لقياس العدل وتمييزه عن الظلم، سوى أنه فرق في جملة من الأمور:
أولاً، بين معيار موضوعي ينشأ من جوف النفس ويتمدّد إلى خارجها، وبين معيار مبتور عن منشئه النفسي.
ثانياً، بين معيار يحتاج الى جهد تربوي وفعل أخلاقي، وبين معيار غير مرتبط بهذا النوع من الجهد والفعل.
ثالثاً، بين معيار قد يختص بمجال محدّد، وبين معيار شامل لجميع القضايا، ولا يمكن أن يخلو منه بعدٌ فردي أو عام.
رابعاً، بين معيار يحتاج بشكل مستديم إلى بنائه وبلورته، والعمل على صوغه، وبين معيار يفتقد إلى هذه الخصوصية.
خامساً، بين معيار يتّسم بشيء من الجمود، وبين معيار يمتاز بشيء من الدينامية الخلّاقة، بمعنى قدرته على توليد معايير جزئية مصداقية موضوعية لجميع القضايا، والوصل ما بين ذاك المعيار على عمومه، وما بين أيّ من القضايا على جزئيتها.
بناءً على ما تقدم، لا بدّ من القول إنّ ما تقدمه هذه الفلسفة الأخلاقية هو أرضية خلّاقة لتوليد معايير موضوعية ملموسة للعدالة. صحيح أنها ليست معنية في وظيفتها المباشرة أن تقدم جميع تلك المعايير في مختلف المجالات ذات الصلة، لكنّها توفر الأساس الصحيح والحق لتوليد تلك المعايير، لأن السؤال الأساس فيما يرتبط بتلك المعايير، ليس كيف يكون المعيار موضوعياً وملموساً، وإنما كيف يكون ذاك المعيار صحيحاً وصائباً، ومن ثم يأتي سؤال التشخّص. أي إنّ الإشكالية الأساس ليس كيف يكون المعيار متشخّصاً، وإنما كيف يعكس ذاك المعيار ماهية العدالة وقيمها ذات الصلة، بأفضل مستوى ممكن. أما موضوع التشخّص فهو أمرٌ تالٍ، وهو نتاج عملية البناء المعياري وآليتها وشروطها.
وبتعبير آخر، إن التحدّي الأهم في إقامة العدالة يكمن في المرتكزات المعرفية والمعنوية والفلسفية القادرة على إقامة عدالة حقّة وصائبة، وليس عدالة مزيّفة أو مشوّهة. أما موضوع التشخيص المعياري، على أهميته، فهو يأتي في مرتبة تالية بلحاظ الأهمية. وإن كانت مهمة التشخيص هذه تحتاج إلى جهد مستأنف، وتنطوي على أهمية خاصة، وتتطلّب شروطاً ثلاثة:
الأول: تحديد المرتكزات المعرفية والفلسفية التي ينبع منها، ويقوم عليها.
الثاني: تحقيق ذلك المضمون الأخلاقي والمعنوي في النفس بفعل التربية والتزكية.
الثالث: معرفة الواقع أو الواقعة التي يراد بناء معيار موضوعي بشأنها.
وهو ما يتيح القيام بعملية وصل ما بين ذاك المضمون الأخلاقي المتحقّق في النفس، وما بين تلك الواقعة، مع ما تحتاجه هذه العملية من عناصر معرفية وعلمية ذات صلة، بما يفضي إلى إنتاج معايير موضوعية وملموسة هي حصيلة التجادل والتفاعل ما بين ذاك المضمون المعنوي والأخلاقي من جهة، وما بين ذاك المضمون المعرفي والواقعي من جهة أخرى.
وعليه، لا يصح القول إن هذه الفلسفة تفتقر إلى المعايير، وإنما هي فلسفة حبلى بها، وقادرة على استيلادها، وإن كانت عملية التوليد هذه عملية مشروطة ومركبة، وتتبع آلية خاصة، لكنها عملية تمتاز بجملة من الخصائص التي تجعل تلك المعايير أقرب إلى الاستجابة للواقع وجميع حاجاته والتباساته، وأقدر على محاكاة العدالة وجوهرها، وأشدّ قدرة على شمولها لجميع الأبعاد من فردية واجتماعية ودولتية ودولية وعولمية، من دون أن تنحصر بمورد وآخر.
نعم قد يصح القول إن هذه العملية تراكمية، بمعنى أنه كلّما تقدّم المجتمع – أو الفرد – في مساره التربوي والتخلّقي، كلما كان أقدر على إنتاج العدالة وإقامة بنيانها. وهذا التقدّم هو تقدّم تدريجي. وهو ما يعني أن القدرة على إقامة العدالة تأخذ منحى تصاعدياً، كلما حثّ المجتمع خطاه في مسيره التكاملي معنوياً وأخلاقياً. وأنها في المقابل تأخذ منحى تنازلياً، كلما ارتكس المجتمع في مسيره ذاك.
وهو ما يعني أن بناء العدالة يتطلب أن يضحى نهجاً يُتبع، وثقافة عامة، ويحتاج إلى جهد مستديم ودؤوب، لا يقف عند حدود بعض المعالجات المادية، كنقل ملكية وسائل الإنتاج، أو توزيع الدخل والثروات الوطنية بشكلٍ أو آخر، وإنما هو مسارٌ يبدأ من منطلقٍ ما، ولا ينتهي عند خاتمةٍ محددة، لأن العدالة إن كانت مرتبطة طرداً وعكساً بذاك المسار المعنوي والتخلّقي، وإذا كان هذا المسار مفتوح في أفقه التكاملي، لأنه سيرٌ معنوي لا نهاية له بالعدل إلى الله تعالى العادل؛ فهذا يعني أن ذاك المسار لا نهاية له، وأنه كلما حقّق مرتبة من مراتب العدالة، تنتظره مرتبة تالية عليها، وأنه كلما بلغ شأواً في سبيلها، يمكن له أن يتطلع الى ما بعده، وأن يطمح الى ما هو أرقى منه. وهو ما يستولد طاقة دائمة على فعل العدل، والبناء عليه.
وقد يترتّب على ما تقدّم أنّ من يتولى الشأن العام في أيّ من موارده، يجب أن يكون ممن تقدّم على غيره في صناعة عدالته الشخصية معرفياً وأخلاقياً ومعنوياً، وأنه كلما كان المنصب في الشأن العام أشدّ أهمية وأبلغ أثراً، كلما كانت الحاجة إلى مرتبة أعلى في صناعة العدالة الشخصية، ونيل كمالاتها، وبلوغ رشدها، وصولاً إلى الإمامة الكبرى، التي تحتاج إلى المرتبة الأشدّ في سلّم تلك العدالة وتراتبيتها، لما لها من الدور الأهم في إقامة القسط وبسط العدل في الاجتماع العام.
نعم، ينبغي التأكيد على أن العدالة الشخصية هنا ليست مجرد معطى أخلاقي بمعناه البسيط، وإنما هي أيضاً معطى معرفي، علمي، ثقافي، فلسفي...حيث ينبغي لهذا المعطى أن يتمدّد ويرتقي أفقياً وعامودياً تبعاً لنوع الشأن العام ومرتبته، أي إنّ هذا المعطى يجب أن يكون من نوع المجال المعرفي والعلمي الذي يرتبط به هذا المنصب أو ذاك، فإذا كنّا نتحدث -على سبيل المثال- في المجال الاقتصادي، فإننا نحتاج –فضلاً عن العدالة الأخلاقية والمعنوية بمعناها الخاص- إلى عدالة اقتصادية في إطارها المعرفي والعلمي. وإذا كنا نتحدّث في المجال السياسي، فنحتاج إلى عدالة سياسية في إطارها المعرفي والعلمي، وهكذا بقية المجالات ذات الصلة. وكذلك الأمر في ارتقاء تلك العدالة تبعاً لمرتبة الشأن العام وطبيعة الوظائف والمهام المناطة به، إذ إنه ينبغي لهذه العدالة أن ترتقي ويرتفع منسوبها بالتوازي مع ذلك المنصب ورتبته، وأن تأخذ نوع المجال المعرفي والعلمي الذي تتطلبه تلك المهام والوظائف.
وهو ما يعني أيضاً أن المجتمعات كما يمكن أن تتقدّم، أو تسرع الخطى في صناعة عدالتها، فإنها يمكن أن ترتكس، أو يتباطأ سيرها أو يضعف في تلك الصناعة ومسارها. ما يوفّر لنا مؤشراً على مستوى الرّقي المعنوي والأخلاقي، والدرجة التي بلغتها المجتمعات في سلّم تكاملها الروحي والتربوي، ليكون منسوب العدالة ومدى حضوره فردياً واجتماعياً وسياسياً واقتصادياً...بمثابة مؤشّر ودليل على ما بلغته تلك المجتمعات في مسارها ذاك، وموضعها منه.
كما لا يفوتنا الإشارة إلى أن القدسية التي تهبها هذه الفلسفة لصناعة العدالة وفعلها، باعتبار كونها طريقاً إلى الله تعالى وسبيلاً إليه؛ تعطي طاقة خلّاقة لتوليد العدالة، والسير في ركابها، والتغلّب على عوائقها، وتحطيم جميع الأصنام التي تحول دونها، عندما تضحى العدالة مقولة لا تقتصر على الاقتصاد والاجتماع والسياسة والقانون.. وإنما تشمل أيضاً الإيمان والعرفان والعبادة والسير إلى الله تعالى والسلوك إليه، والآخرة وأهوالها، كما الدنيا وأحوالها.
ومن هنا، يمكن لنا أن نعي فلسفة ذلك الوصل بين خروج إمام العدالة –المهدي(ع) من أهل البيت(ع)- في نهاية التاريخ، وبين ما نصّت عليه بعض الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت(ع) من أنّ الإمام المهدي(ع) "يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، بعدما ملئت جوراً وظلماً "([11])؛ حيث إنّ المهدي(ع) هو إمام الهداية المعنوية([12])، وهو الهادي في طريق السير والسلوك إلى الله تعالى، وتحقيق عبوديته، والخروج من جميع العبوديات الأخرى. وهو من هذه الجهة إنّما يدفع البشرية نحو عدالتها، ويقودها لإقامة القسط لديها. لأنّ العدالة إذا ما كانت موصولة بالسير المعنوي والتكامل التخلّقي، وإذا كان المهدي(ع) هو من يأخذ بيد تلك البشرية قدماً في سيرها المعنوي ذاك، وسبيل تكاملها التخلّقي مورد الذكر؛ فهو ما يعني أن المهدي(ع) إنما يحقّق لها بذلك عدالتها، ويملأ بهدايته أرضها قسطاً وعدلاً.
وهو لا يتنافى مع مجمل الروايات الأخرى ذات الصلة، والتي يستفاد منها أن الإمام(ع) يقطع جذور الظلم بقوة السيف، ويكنس الجور بمنطق التدافع، وذلك لأنّ إقامة العدالة في الاجتماع العام تحتاج إلى فعلٍ جمعي، وتكاملٍ اجتماعي، بمعزل عن مجمل الظروف والعوامل التي تهيىء أرضية مناسبة لتحقيق هذا التكامل، وتساعد عليه. وإن كان ما يستفاد من مجمل تلك الروايات تلك أن العديد من الظروف والعوامل والأسباب، سوف تكون مساعدة إلى أبعد مدى في نهاية التاريخ وأوان الخروج على تحقيق ذلك التكامل المعنوي، و مؤدية إلى الدفع قدماً في طريق السير التخلّقي([13])، وهو ما سوف يسهم في هداية البشرية إلى عدالتها، وقيادتها إلى إقامة القسط لديها. وهو ما يحتاج إلى بحثٍ مستأنف.
ولذلك هذه العدالة التي نبحث فيها هي:
1- معنوية أخلاقية، موطنها الأول في النفس، منه تنشأ، وإليه تعود.
2- وإن كانت نفسية المنشأ، لكنها قابلة للتمدّد خارج النفس في الواقع الخارجي.
3- فردية واجتماعية، فكما لها فضاؤها الفردي، لها أيضاً مجالها العام وفضاؤه.
4- قادرة على إنتاج معايير جوانية وجدانية، تمنح الفرد قدرة ذاتية على التقييم العدالتي.
5- المعيارية الفردية للعدالة إنحلالية، بمعنى أنها تنحلّ إلى معايير جزئية بعدد الأفراد.
6- تختلف قدرة ملامسة المعايير الفردية لواقع العدالة تبعاً للرقي المعنوي والخلقي للأفراد.
7- من هنا توجد حاجة دائمة للّجوء إلى معايير موضوعية، والاستناد إلى الأشدّ عدالة.
8- تملك دينامية خاصة لانتاج معايير موضوعية تحاكي حاجات الاجتماع العام وانتظامه.
9- تحتاج إلى عملية وصل مع الواقع الخارجي، ضمن آليات خاصة تتيح ذلك الوصل.
10- عملية الوصل تلك، تقوم على بعدين اثنين: معنوي أخلاقي، وواقعي موضوعي.
11- تملك خلّاقيتها الفذّة لإنتاج معايير أبعد تفصيلاً وأشدّ جزئية لأيّ من القضايا ذات الصلة.
12- تحيل صناعة العدالة إلى فعلٍ مستديم وجهدٍ دائم، لا يبلغ نهايته، ولا يقف عند مسعى.
13- صناعة العدالة عملية تراكمية، فكلما بلغت رتبة تنتظرها أخرى، أعلى من سابقتها وأرقى.
14- تملك قدسيتها الخاصة، بما يفضي إلى وجود قوّة دفع ذاتية لإنتاجية العدالة واستدامتها.
15- ترتّب مسؤوليتها الخاصة، بمعنى أنها كما تنتج معاييرها، فإنها تملك قدرة الإلزام بها.
16- صناعة تلك العدالة في الإطار الفردي والجمعي أمرٌ اختياري، يحصل بكامل الاختيار.
17- تحتاج دوماً إلى الهداية المعنوية، ومعاني الدين الخالص، بما تسهم به في تلك الهداية.
18- يمكن أن تشترك فيها جميع الأديان والفلسفات والمذاهب التي تؤمن بتلك القيم ومقاصدها.
19- تملك تأويلها فيما يتّصل بفلسفة المهدوية وحركة التاريخ ونهايته.
20- تقدّم رؤية خلاصية سواءٌ في الإطار الفردي أم الاجتماعي أم الدولتي، بل حتى في إطار العولمة وانسدادها الحضاري.
1- أنظر: محمّد شقير، فلسفة العدالة وإشكاليّات الدّين والدّولة والاجتماع الإنساني، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، 2019 م، ط1، صص 25- 32.
1- لقد وجدنا نوع مقاربة لهذا المضمون لدى "أمارتيا سن"، من خلال ما يصطلح عليه ب(التفكير المحايد). أنظر: فكرة العدالة، ترجمة مازن جندلي، الدار العربية للعلوم، بيروت، 2010م، ط1، ص 11.
1- يمكن الحديث في هذا المورد عن العدالة في العرفان، والوصل ما بين قيمة العدالة وعلم العرفان بشقيه النّظري والعملي. وهو ما يتيح اكتشاف البعد العرفاني في العدالة، وإدخالها في منظومة العرفان، وصيرورتها مقولة عرفانيّة بامتياز.
2- من هنا نعرف كيف تكون عبادة الله تعالى –وفي قلبها الصلاة- طريقاً إلى إقامة العدل في الأرض، لأنها سببٌ لإقامة العدل في النفس، إذ إنّ العبادة سبيل العبودية، وإذا سكنت عبودية الله تعالى في النفس خرجت منه جميع العبوديات الأخرى، وهو ما يفضي إلى العدالة والإنصاف، شرط أن تؤدّى تلك العبادة بكيفية هادفة ومثمرة وموصلة إلى غاياتها ومقاصدها، وإلاّ كانت عبادة عقيمة، لا قيمة لها ولا معنى.
1- في العلاقة بين الدّين والعدالة يمكن الرجوع إلى: م.ن.، صص 33- 62.
2- يمكن الوصل بين فلسفة العدالة هذه، وبين فلسفة المهدويّة في رؤيتها إلى حركة التّاريخ ونهايته، ولا يوجد من تنافٍ بينهما. أنظر: محمّد شقير، فلسفة المهدويّة: العدالة ونهاية التّاريخ، دار المعارف الحكميّة، بيروت، 2018م، ط1، صص 49- 86.
1- أنظر في هذا الموضوع: محمّد شقير، إشكاليّات التّكفير والمذهبيّة والرّافضة، دار المودّة، بيروت، 2016م، ط1، صص 70- 84.
1- وفي هذا المورد، قد يؤخذ على ما ذهب إليه " جون رولز" في كتابه "العدالة كإنصاف"، حيث يقول معبّراً عن فلسفته في العدالة: "العدالة كإنصاف ليست عقيدة دينيّة أو فلسفيّة أو أخلاقيّة... هي مفهوم سياسي للعدالة... ومن هذه النّاحية هي أضيق في مجالها من العقائد الأخلاقيّة الفلسفيّة الشاملة..". ترجمة حيدر حاج اسماعيل، مراجعة ربيع شلهوب، ط1، المنظّمة العربيّة للتّرجمة، بيروت، 2019م، ص 81.
1- محمّد شقير، فلسفة العدالة وإشكاليّات الدّين والدّولة والاجتماع الإنساني، م.س، صص 65- 71.
1- في الدّولة والعدالة يمكن الرّجوع إلى: م.ن، صص 84- 141.
1- الصدوق، الخصال، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1403ه.ق، ص396.
2- أنظر: محمد حسين الطباطبائي، الشيعة، ترجمة جواد علي، مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر، 1416ه.ق، ط1، ص212-213.
1- يمكن أن يستفاد هذا المعنى من العديد من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت(ع)، من قبيل ما جاء عن الإمام الباقر من أنه: "إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد، فجمع بها عقولهم، وكملت به أحلامهم"( الكليني، الكافي،دار الكتب الإسلامية، طهران،1363ه.ش،ط5، ج1، ص25)، حيث إن ما يفهم من هذه الرواية حصول نوع من العناية الإلهية الخاصة، أو التدخل الإلهي من خلال الإمام المهدي(ع) في وعي الناس ووجدانهم، الذين لديهم استعدادٌ ما لتلقّي هذه العناية، وتقبّل هذا الفيض، بما يؤدي إلى أن يكون لديهم مستوى متقدّم من حضور العقل وفاعليته في مقابل الهوى وتأثيره، وبما يوصل إلى اكتمال الوعي العقلي في مقابل التفكير الانفعالي، وهو ما يساعد بشكل أفعل على الخروج من عبودية جميع الأهواء، والدخول بشكل أشدّ في عبودية الله تعالى، بما يفضي أكثر إلى صناعة العدل، والبعد عن الظلم. حيث سيكون من الصحيح منهجياً الوصل بين مجمل المضمون الروائي ذي الصلة، وبين فلسفة المهدوية ومقاصدها، التي تتمحور بشكل أساس حول العدالة وغاياتها.
عدد قراءات المقال : 1622
تعليقات الزوار
جديد الموقع
الإعلان